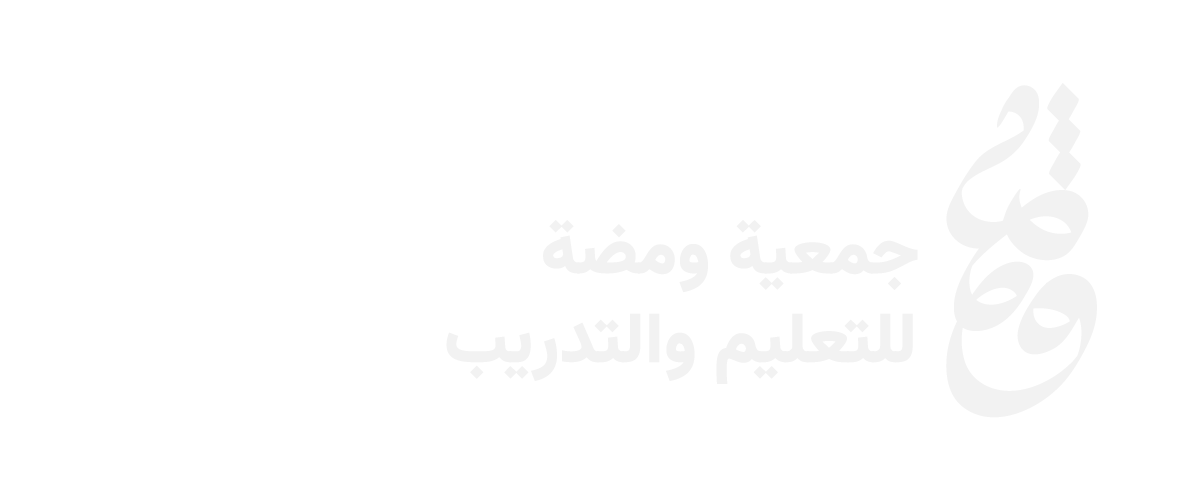وجدتني أنطقُ بهذا الجملة وأنا أفكر في كثرة من لُقّب بالجاحظ، من ابن العميد إلى عبد العزيز البشري، وربما كانا هذين أبعدَ اثنين من الجاحظ، أبعدَ من أبي حيّان التوحيدي ومن الرافعي، وما أبعدَ منهما إلا طه حسين وأحمد أمين، بخلاصة العبارة: كلّهم على حدٍّ واحدٍ في البُعد، ثم هم يتفاوتون فيما بعد ذلك الحدّ، فلا صحّة لما يقوله بديع الدين الهمذاني -وهو أحد مقلدي الجاحظ-: “ولكلّ زمنٍ جاحظ”، إلا على سبيل الزعامة الأدبية والريادة الثقافية، ففي هذا المضمار يَسوغ الانضمام إلى حلبة الجاحظ، باعتبار التأثّر به واستلام شارة القيادة، فالحقّ أن كلّ أولئك الأدباء إنما كانوا أشدّ المعجبين بالجاحظ، وأكثرهم انتفاعاً بأدبه!
ولا ريب أن تلك الجملة، أعني: “لا جاحظ إلا الجاحظ”، تسامت من أن تكون ضمن متن المقالة إلى أن تكون عنواناً لها، وحُقَّ لها، وكلُّ جملة أعرفُ بموقعها من كاتبها، والقارئُ من نفس محيطي سيُدرك لأوّل وهلة أن هذه الجملة على مِنوال دعايةٍ لمطعم شهير اسمه (الطازج)، يُسوِّق لنفسه بعبارة “لا طازج إلا الطازج”، ولو أعملنا فيها التحليل البلاغي لقلنا: يُريد بها القصر الحقيقيّ وربما التحقيقيّ، وواقعُ الأمر أنه قصر إضافيٌّ نُظر فيه إلى مطاعم أخرى يُعتقد فيها ما يَعتقدُ مطعم الطازج في نفسه، ومن سالف الأيام أني كنتُ في هذا المطعم أنتظرُ طلبي الذي تأخّر، بسبب زحمة الطلبات، والتزامه بشرطه في ذلك الإعلان من تقديم وجباته طازجة، فتململتُ حتى ضَجِرت حتى دخلت بين الصفوف الأماميّة، أعترض بما رأيته عيباً في المطعم، قلتُ للعامل الهنديّ: يا صَديق، سَريع سَريع، مضى لي نصف ساعة أنتظر طلبي! فمدَّ رأسه من طاولة تجهيز الطعام، قائلاً: إنت تقول كذا وترجع مرة ثانية تشتري من الطازج، هذا طازج، صح! قلتُ وأنا مبهوتٌ من جوابه: صح! فتذكرتُ ما نقله الجاحظ -لاحظ أنّا لا نستغني عن الجاحظ- من قول بعض الهنود: جِماعُ البلاغة البصرُ بالحُجّة والمعرفةُ بمَواضع الفُرصة!
لا بأس، فجملةُ “لا طازجَ إلا الطازج” من الجمل الاعتيادية التي لا تُمثّل كاتباً فحلاً كالجاحظ مثلاً، ولا زماناً دون زمان، ولا مكاناً دون مكان، ولا ثقافةً دون ثقافة، فكلُّ أحدٍ يَملِك أن يضع في هذا التركيب ما يراه صالحاً للقصر والحصر، تماماً كما فَعلَ محقّق الجاحظ المعروف عبد السلام هارون حين أراد محاكاة الجاحظ في طريقته، فأحضر تراكيب الجاحظ وملأها بألفاظه هو، فلم تَحمِل روحَ الجاحظ، ولكنّه العشق الذي عَلِق بعبد السلام هارون من طُول ملازمته لنصوص الجاحظ، حتى سوَّلت له نفسُه أن يخاطب قارئه في مقدّمة نشرته لرسائل الجاحظ بقوله: “كتبتَ إليّ -حفظك الله- أنْ أسعى سعياً حثيثاً في إظهار ما بَقِي من آثار شيخنا الجاحظ، وزعمتَ أنّي شُغِلتُ عنه بغيره، وكدتَ أنْ تَلومني لِما فرطتُ في جَنب أبي عثمان فيما رأيتَ”!، لكنها محاولةٌ مقبولةٌ تربط بين المحقّق والمؤلّف في نَسَق واحد، يُتيح للقارئ -على الأقل- أن يطمئِن لصدقِ الصَّداقة بينهما!
واحدٌ من الأدباء يمكن أن يرفع يده في حضرة الجاحظ، ويُجاريه دون أن يُحاكيه، هو أبو حيّان التوحيديّ، الذي أُعِجب بالجاحظ وألّف كتاباً في “تقريظ الجاحظ”، الجاحظُ وحدَه عند أبي حيّان هو مَن يستحق التقريظ، أمّا البقيّة فأبو حيان لا يكاد يُعجبه أحدٌ، ولا يكاد يسلم منه أحدٌ، حتى مَن قيل بأنّ الكتابة قد خُتِمت به، وهو ابن العميد، يقول أبو حيّان
في كتابه (الإمتاع والمؤانسة): “سمعتُ ابن الجمل يقول: سمعت ابن ثوّابة يقول: أوّل من أفسد الكلام أبو الفضل -أي ابن العميد-؛ لأنه تخيّل مذهب الجاحظ، وظنّ أنه إن تبعه لحقه، وإن تلاه أدركه، فوقع بعيداً من الجاحظ، قريباً من نفسه، ألا يعلمُ أبو الفضل أنّ مذهبَ الجاحظ مدبّرٌ بأشياء لا تلتقي عند كلّ إنسان، ولا تجتمع في صدر كلّ أحد، بالطبع والمنشأ والعلم والأصول والعادة والعمر والفراغ والعشق والمنافسة والبلوغ، وهذه مفاتحُ قلّما يملكها واحد، وسِواها مغالقُ قلّما ينفكُّ منها واحد”!
أبو حيّان يؤكّد أنْ لا جاحظَ إلا الجاحظ إلا إذا تآزرت هذه الأسباب العشرة واجتمعتْ في رجل كما اجتمعتْ في الجاحظ، وأنّى يكون ذلك؟ وكلُّ مَن أراد أن يكون جاحظَ زمانه فسيقع بَعِيداً من الجاحظ، قريباً من نفسه، كما لا يريد أن يكونه، وهذا الوقوع بعبارة أبي حيّان هو مرادفٌ للسُّقوط؛ لكأنّ الجاحظ قمّة يتساقط مِن على جوانبها كلُّ من ابتغى الصّعود إليها!
هي عشرةُ أسباب متآخيةٌ كوّنت أدب الجاحظ، وصعّبت من اللّحاق بالجاحظ، كما يرى أبو حيّان، ونرى أن تلك الأسباب العشرة تلخّصت في اسمه الثلاثيّ الذي قلّما يجتمع في أحد، فهو عمرو بن بحر بن محبوب: أدبه مُعمَّرٌ، وثقافتُه بحرٌ، وأسلوبه محبوبٌ، وإن شئت فقل: الجاحظ المعمّر، والجاحظ البحرُ، والجاحظ المحبوبُ، اسمٌ طابق المسمّى، كما لا يحدثُ كثيراً في عالم الأسماء والمسمّيات!
أمّا الجاحظ المعمَّر فقد عاش قرابة المائة سنة، قال يَشكو في أواخر حياته من الفالج والنُّقرس: “أنا في هذه العِلل المتناقضة التي يتخوّف من بعضها التَّلَف، وأعظمها ستٌّ وتسعون سَنة”!
هذا العمرُ الطويلُ ساعده على كثرة التأليف في جَليل الأمور وحقيرها، وقد أربتْ مؤلّفاته على الثلاثمائة مؤلّفاً، حتى قال المسعودي عنه: “ولا يعلم أحدٌ من الرواة وأهل العلم أكثر كتباً منه”، وكان يصنّف في أغلب موضوعات كتبه على غير مثال سابق؛ مما أتاح لمؤلفاته حسن التأثير والخلود وبُعد الصِّيت!
وأمّا الجاحظ البحر فقد التهمَ عمرو بن بحر علمَ سابقيه، فلم نعد نعرف أبا عبيدة معمر بن المثنى، مع أن تصانيفه تقارب المائتين مصنفاً، وقد قال الجاحظ فيه: “لم يكن في الأرض خارجيٌّ ولا جماعيٌّ أعلمُ بجميع العلم منه”، ولا هشام بن محمد الكلبي الذي أُحصيت مؤلّفاته بنحو مائة وتسعة وثلاثين مؤلّفاً، ولا المدائني الذي أحصيت مؤلّفاته في نحو مائتين وأربعين مصنفاً!
وفيما يبدو أنه قرأ كلّ الكتب المدوّنة في عصره، وزاد عليها بتدوين معارف عصره، يتمثّل قولَه: “فالإنسانُ لا يعلم حتى يكثر سماعه، ولا بدّ من أن تكون كتبه أكثر من سماعه، ولا يعلم، ولا يجمع العلم، ولا يُختَلف إليه، حتى يكون الإنفاقُ عليه من ماله، ألذّ عنده من الإنفاق من مال عدوّه، ومن لم تكن نفقته التي تخرج في الكتب، ألذّ عنده من إنفاق عشّاق القيان، والمستهترين بالبنيان، لم يَبلغ في العلم مبلغاً رضياً”!
وأمّا الجاحظ المَحبوب، فقد سرى حبّ الجاحظ للعلم والثقافة والكتاب من قوّته إلى قارئه، فلا تجد حميميّة تشتدّ بين مؤلّف وقارئ كما تجد ذلك بين الجاحظ وقارئه، أحبّه المؤتلف معه في نِحلته والمختلف، لقد تَوارَى -كما يقول طه الحاجري- الجاحظُ القبيح الصورة البذّ الهيئة خلفَ الجاحظ الذكيّ المُبدِع الظريف الرائع الحجّة الفصيح اللسان، لم تكن طرافته فحسب هي مصدر قُربه من قارئه، بل كانت واقعيّته وتودده لقارئه بأسلوبه الأخّاذ وفكرِه المتوهّج هي مصدر محبّته وقُربِ أدبه!
إنه الأديبُ الذي يَرتقي معه قارئه ولا يستطيع أن يكون مثله، فضلاً عن أن يَعلو عليه، مهما تأثّر بأدبه، وأحبَّ أسلوبه، وحَفِظَ نصوصه، ولو تكرّر الجاحظُ لما كان الجاحظُ الجاحظَ!
![]()
![]()