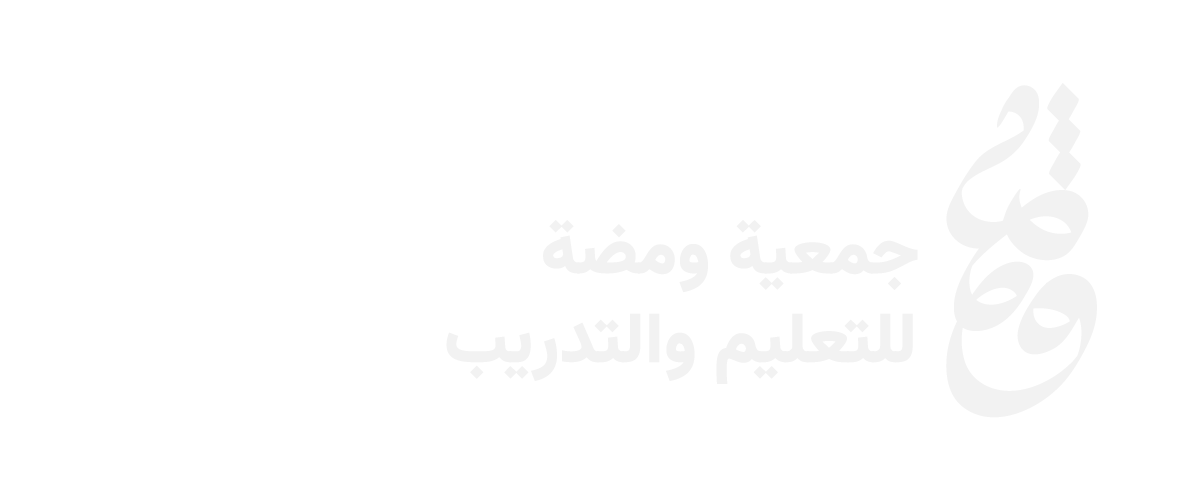تقوم مهمة النقد على تفسير العمل الأدبي للقارئ، لمساعدته على فهمه وتذوقه، وكشف إمكاناته، وبالتالي اتخاذ موقف من هذا العمل. فالناقد لا يقف عند حدود الانطباع العابر أو القراءة السطحية، بل يقوم بعملية منهجية تبدأ بافتراض وجود الأدب كخطاب يحمل قيمة، ثم البحث عن طبيعته وشرحها وإيضاحها، ليُنتج بعد ذلك رأياً يساعد في إدراك أبعاده العميقة، ويُعيد تشكيل العلاقة بين النص وقارئه. وبذلك يصبح الناقد وسيطًا معرفيًا، يكشف المخبوء، ويضيء المعتم، ويمنح النص حياة أخرى خارج حدود مؤلفه
قال لي أحدهم: «أعان الله النقاد على أنفسهم، فهم مشغولون بغيرهم دائماً».
جعلتني هذه العبارة أتأمل صورة الناقد في عين الأديب: كيف يراه؟ أهو العدو الذي يتربّص بنصوصه ليكشف عثراتها؟ أم الصديق الذي يمنحها حياة جديدة حين يضيئها بالقراءة والتأويل؟ وهل يستطيع الأديب أن يكتب نصوصه بمعزل عن النقد، أم أن النص لا يكتمل إلا حين يجد قارئًا يشرحه ويضعه في سياقه، ليصبح جزءًا من الذاكرة الثقافية؟
الأديب حين يكتب يعيش حالة معقدة، إذ يتنازعه صوتان متناقضان: صوت الخوف وصوت الرغبة. فهو يخشى الناقد، لأنه صاحب الكلمة التي قد تُسقط نصه في عيون القراء، أو تحاصره بأحكام جائرة لا ترحم. لكنه في الوقت ذاته يرغب في التميز، وينتظر لحظة الاعتراف التي لا تكتمل إلا حين يضع الناقد نصَّه تحت الضوء. وكأن الأديب، وهو يكتب، يكتب للغائب الحاضر: الناقد الذي يخشاه ويريده في آن واحد. وهنا يظهر السؤال: هل يكتب الأديب من أجل القارئ العام، أم من أجل الناقد المتخصص، أم من أجل ذاته وحدها؟ وأيّ هذه الجهات أصدق في تحديد القيمة الحقيقية للنص؟
الناقد بدوره ليس متفرجًا محايدًا، بل هو شريك في صناعة المعنى. عبدالقاهر الجرجاني حين تحدّث في دلائل الإعجاز عن «النظم»، أكّد أن جمال المعنى لا يكتمل إلا إذا أبرز الناقد وجوه هذا النظم وكشف عن دقائقه، أي أن النص يحتاج إلى قراءة ثانية تعيد صياغته وتفتحه على احتمالات جديدة. لكن هذه الشراكة كثيرًا ما تتحوّل إلى صراع، لأن الأديب يرى في الناقد سلطة قد تتحول إلى قيد. فالناقد، بما يملك من أدوات ومعايير، قد يفرض رؤيته على النص، فيحدّ من حريته ويقصره على معنى واحد، في حين أن الأدب بطبيعته ينزع إلى التعدد والانفتاح.
في زمن مضى، كان الأديب يترقب ما تكتبه الصحف أو ما يقوله النقاد في الندوات، وكان النقد يملك وزنًا اجتماعيًا لا يقل أثرًا عن النصوص ذاتها. أمّا في زمننا الرقمي، فقد تغيّرت ملامح هذه العلاقة؛ إذ لم يعد الناقد المتخصص وحده صاحب الكلمة الفصل، بل دخلت أصوات القراء، والمدونين، وكتّاب المراجعات السريعة على مواقع التواصل والمنصات الإلكترونية. هذه الأصوات الشعبية أزاحت النقد الأكاديمي جانبًا، وصارت قادرة على صناعة صورة لعمل أدبي أو تشويهه في لحظات قليلة. فهل خفّ ذلك من خوف الأديب من الناقد؟ أم زاد قلقه حين وجد نفسه في مواجهة نقدٍ متفلّت، سريع، وعابر، لا يرحم؟
ورغم هذا التحول، فإن الحاجة إلى النقد المتخصص لم تتراجع. بل ربما ازدادت إلحاحًا في زمن يُقاس فيه كل شيء بالسرعة والانتشار. فإذا كان القارئ العادي يلتقط الانطباع الأولي، فإن الناقد هو من يمنح النص حياة أبعد من اللحظة العابرة، إذ يربطه بسياقه الثقافي، ويكشف طبقاته، ويُظهر جمالياته التي قد تغيب في ضجيج التلقي السريع. ومن هنا يتجدد السؤال: هل النقد اليوم ترفٌ يمكن الاستغناء عنه، أم هو صمّام الأمان الذي يحمي الأدب من التبسيط المفرط والابتذال؟
الخوف الذي يشعر به الأديب أمام النقد ليس خوفًا سلبيًا بالضرورة؛ فقد يكون دافعًا للتجويد والبحث عن العمق. فكثير من النصوص الخالدة في تاريخ الأدب لم تكتسب قيمتها الكاملة إلا بعد أن صمدت أمام القراءة النقدية، أو بعد أن أثارت جدلًا نقديًا كشف عن ثرائها. لكن الخوف إذا تجاوز حدوده الطبيعية تحوّل إلى عائق، إذ يجعل الأديب أسيرًا لرضا الناقد، فيكتب بنية إرضائه لا بنية التعبير الحر. وهنا يفقد النص صدقه، ويتحول النقد من محفّز للإبداع إلى سيف يقطع أوصاله.
أما الاحتياج، فهو الجانب الآخر من المعادلة. فلا أديب يمكنه إنكار حاجته إلى النقد. النص من دون قراءة واعية يبقى تجربة فردية مغلقة، لكن النقد يمدّه بالقدرة على الانتشار والتأثير. ومن المفارقات أن كثيرًا من الأدباء الذين أعلنوا تمردهم على النقاد أو رفضهم لهم، لم يكن تمردهم إلا نوعًا من الاعتراف الضمني بسلطة النقد عليهم، فالمواجهة لا تكون إلا مع خصم مؤثر.
وحين ننظر إلى واقع الأدب العربي اليوم، نجد أن هذه الجدلية حاضرة بوضوح: فالأديب يريد التميز وسط ازدحام النصوص وتكاثر الأصوات، والناقد يريد أن يؤكد دوره في عالم لم يعد يمنح الكلمة الواحدة نفس الوزن القديم. كلاهما يسعى لإثبات ذاته، وكلاهما يحتاج إلى الآخر ليحقق المعنى الكامل لما يقوم به. وهنا يظهر السؤال المفتوح: هل يمكن أن نتصور أدبًا بلا نقد؟ وهل يمكن أن نتصور نقدًا بلا أدب؟
إن الإجابة لا تكتمل، لأن العلاقة نفسها قائمة على التوتر والحوار. فالأديب يهرب من الناقد بقدر ما يترقبه، ويخاف سلطته بقدر ما يسعى وراء اعترافه، والناقد يمارس سلطته على النص لكنه لا يستمدها إلا منه. في هذا التبادل غير المستقر تكمن حيوية الثقافة، وفي هذا الشدّ والجذب يتجدّد الأدب وتجدّد معه مهمة النقد.
وبين الخوف والاحتياج، تبقى الحقيقة أن الأدب بلا نقد يظل نصًا ناقص الحضور، والنقد بلا أدب يظل خطابًا بلا مادة. وإذا كان الأديب يسعى إلى الخلود عبر نصوصه، فإن الناقد هو من يمنح هذا الخلود سياقه ومعناه. وهكذا يستمر الحوار، لا بين شخصين فقط، بل بين ضفتين تمثلان معًا نهر الثقافة الإنسانية المتجددة.
![]()
![]()