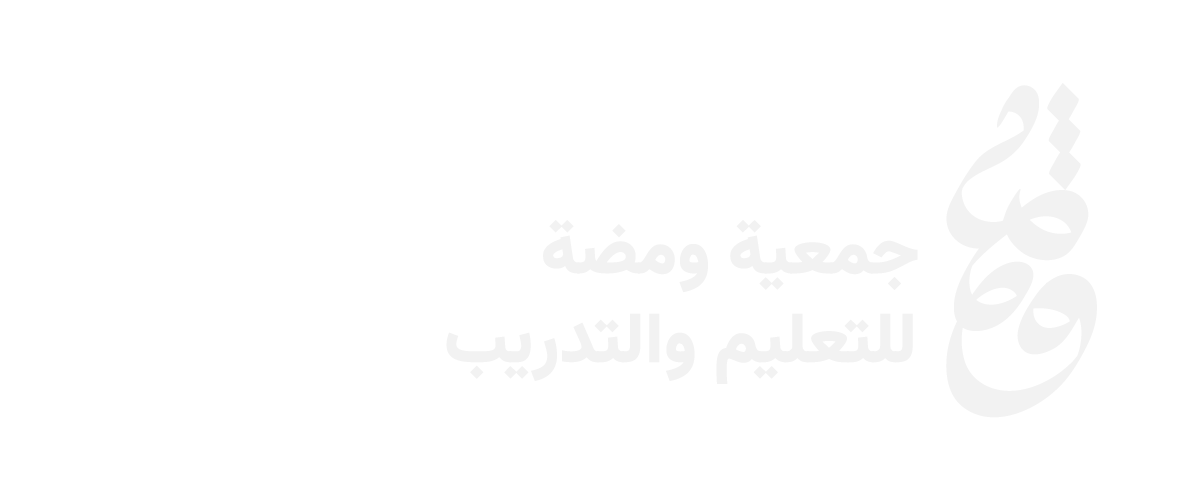التعالم داء خطير وبلاء مستطير ابتليت به الأمة على تعاقب أجيالها وتطاول قرونها، وهو في حقيقته ادعاء الشخص العلم والخبرة دون امتلاك أسسهما الحقيقية، مع التطلع لنيل منزلة أهل الاختصاص بين الناس. ولقد تفاقمت هذه الآفة في عصرنا بسبب تسارع المعلومات وانتشار وسائل التواصل، حتى صارت من أعظم التحديات التي تواجه البناء المعرفي للأمة.
التأصيل الشرعي لخطورة التعالم
لقد حذر الله تبارك وتعالى من جوهر هذه الآفة في محكم تنزيله، فقال عز من قائل: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33].
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: “فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريمًا منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهما وهو الشرك بالله سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريمًا من ذلك كله وهو القول عليه بغير علم”.
وفي السنة المطهرة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من انتشار هذه الظاهرة فقال: “إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمًا، اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فَسُئِلُوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا“ متفق عليه. وفي هذا إشارة بينة إلى خطورة تصدر غير المؤهل للفتوى والتعليم.
سمات المتعالم وعلاماته
يتَّسم المتعالم بعدة سمات تكشف حقيقة أمره للناظر المتبصر، فمن ذلك:
- السطحية المعرفية : إذ تتسم معرفته بثقافة عامة يتقمَّشُها من هنا وهناك.
يقول سحنون بن سعيد: “أجسر الناس على الفتوى أقلهم علمًا، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه”.
- الجرأة على القول بغير علم: ولا سيما في فقه النوازل، ولو أنه سئل في مسألة من أحكام الصلاة ما عرف لها جوابًا، قال ابن القيم: “ولا يفتي في النوازل إلا عالم بالكتاب والسنة”. وروي عن غير واحد من السلف: “من قال برأيه فقد أخطأ وإن أصاب” ، وزاد آخرون: “من قال في القرآن برأيه…”. وقد قال ابن عباس بشأن من يفتي في كل شيء وهو من أهل العلم: “إن كل من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون”. فماذا يكون شأن المتعالم؟
- التفاصح بالمصطلحات: يكثر من استعمال الألفاظ المعقدة دون إدراك حقيقي لمعانيها، وهذا من علامات التكلف المذموم.
- حب الظهور والشهرة: فغايته نيل إعجاب الناس وتقديرهم، لا خدمة الحق ونفع الخلق، وهذا مما ينافي أدب العلم وحرمته.
- شهوة الكلام والثرثرة: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “..وإنَّ أبغضَكم إليَّ وأبعدَكم منِّي في الآخرةِ أسوَؤُكم أخلاقًا الثَّرثارون المُتفيهِقون المتشدِّقون”.
- النفور من النقد والتصحيح: فيتفاعل بحساسية مفرطة مع أي تنبيه أو تصحيح لأخطائه، ويأنف من الاعتراف بجهله، على عكس أهل العلم الراسخين.
- إغفال التوثيق والاستدلال: نادراً ما يستند إلى مصادر معتبرة أو يذكر أدلة صحيحة، وهذا مما يخل بأمانة النقل العلمي.
أسباب استفحال التعالم
العوامل التقنية المعاصرة
- ثورة المعلومات: أدت سهولة الوصول للمعلومات إلى خلق وهم لدى كثيرين بأنهم صاروا خبراء في مختلف المجالات، والحق أن العلم ليس مجرد معلومات تُجمع، بل ملكة تُحصل بالدربة والممارسة تحت إشراف أهل الاختصاص.
- منصات التواصل الاجتماعي: وفرت مساحة واسعة للتعبير عن الآراء دون رقابة علمية حقيقية، مما أتاح لكل أحد أن يدلي برأيه في شتى المسائل بعلم أو بغير علم.
- ثقافة الشهرة السريعة: حيث يسعى كثيرون لتحقيق المتابعة والشهرة على المنصات الرقمية، فيدعون الخبرة والاختصاص طلبًا للأضواء.
العوامل التعليمية والثقافية
- ضعف التأسيس المنهجي: بإهمال تعليم مناهج البحث والتفكير النقدي في النظم التعليمية، وكما قال السلف: “لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف”.
- غياب القدوات العلمية الراسخة: وضعف تأثيرهم في المجتمع، مما ترك فراغًا ملأه المتطفلون على العلم والمتعالمون.
- التعجل في ادعاء العلم: دون صبر على مراحل التحصيل الطبيعية ودرجاته المتتالية، والعلم كما قال السلف: “لا يُعطيك بعضَه حتى تُعطيَه كلَّك”.
مخاطر التعالم وأضراره
المخاطر المعرفية
- إفساد الحقائق العلمية: فالمتعالم ينشر المعلومات المحرفة ويشوه الحقائق الثابتة، وكما قال عبد الله بن المعتز: “زلة العالم كانكسار السفينة، تغرق ويغرق معها خلق كثير”.
- زعزعة الثقة في العلم الحقيقي: إذ أن أخطاءه الفادحة تنفر الناس من العلم الصحيح وأهله، وتضعف مكانة المؤسسات العلمية والمراكز المتخصصة.
- خلط المفاهيم: فيمزج الحق بالباطل حتى يصعب على العامة التمييز بينهما، وهذا من أعظم المفاسد المعرفية.
- المخاطر الاجتماعية والحضارية
- تفكيك النسيج الاجتماعي: بإثارة الخلافات العقيمة وتفريق الناس بالجهل، فيصير كما قال ابن حزم: “لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها، وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون”.
- عرقلة التقدم الحضاري: بتعطيل الاستفادة من العلم النافع وترويج النظريات الباطلة والادعاءات الفارغة، مما يؤخر النهضة الحضارية المنشودة.
الفاصل بين المتعالم والعالم
صفات العالم الراسخ
العالم الحق يتميز بصفات تميزه عن المتعالم تمييزًا واضحًا:
- التواضع العلمي الجمّ: فيقول “لا أعلم” دون حرج عندما لا يتيقن من المسألة، وقد روي عن الإمام مالك أنه سُئل عن ثمان وأربعين مسألة، فقال في اثنتين وثلاثين منها: “لا أدري”. وقال مالك رحمه الله: “من فقه العالم أن يقول: لا أعلم، فإنه عسى أن يتهيأ له الخير”.
- الدقة في التخصص: عملاً بقول الحافظ ابن حجر: “إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب”.
- الاستدلال والتوثيق: فيعتمد على المصادر الموثوقة ويذكر الأدلة والبراهين، ولا يقول إلا بعلم من الكتاب والسنة أو إجماع المسلمين.
- قبول النقد والتصحيح: فيرحب بالنقد البناء ويعده فرصة للإصلاح والتطوير، وكما قال القاسم بن محمد: “من إكرام الرجل نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه”.
منهجية العالم الحقيقي
- البحث والتحري: فيتثبت من المعلومات ويدقق فيها قبل نشرها، وكما كان أيوب السختياني إذا سأله السائل قال له: أعد، فإن أعاد السؤال كما سأله أولاً أجابه، وإلا لم يجبه.
- التطوير المستديم: فيواصل تحصيل العلم وتجديد معارفه، لأن العلم بحر لا ساحل له.
- المحاسبة الذاتية: فيراجع آراءه ومواقفه ويصححها عند الحاجة، وهذا من أمارات الرسوخ في العلم.
تورع السلف عن الفتوى
لقد كان السلف الصالح مع علمهم الغزير وفقههم العميق يتورعون عن الفتوى ويهابونها هيبة عظيمة:
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ: “أَدْرَكْتُ عِشْرِينَ وَمِئَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَ مِنْهُمْ مُحَدِّثٌ إلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْحَدِيثَ، وَلَا مُفْتٍ إلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُتْيَا”.
أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ آيَةٍ، فَقَالَ: “أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي؟! وَأَيْنَ أَذْهَبُ؟! وَكَيْفَ أَصْنَعُ إذَا أَنَا قُلْت فِي كِتَابِ اللَّهِ بِغَيْرِ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا؟!”.
ابْنُ عُمَرَ سأله أعرابي عن ميراث العمة فقال: “لا أدري”، فتعجب الأعرابي، فقبَّل ابن عمر يديه وقال: “نِعْمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ سُئِلَ عَمَّا لَا يَدْرِي فَقَالَ: لَا أَدْرِي”.
الشَّعْبِيُّ قيل له: “إنا لنستحيي من كثرة ما تُسأل فتقول: لا أدري”، فقال: “لكن ملائكة الله المقربون لم يستحيوا حيث سئلوا عما لا يعلمون أن قالوا: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾”.
وقال الشعبي: “لا أدري (هي) نصف العلم”.
التعالم في العصر الرقمي: تحديات وفرص
التحديات المستجدة
- سرعة انتشار المعلومات الخاطئة: إذ تنتشر المعلومات المغلوطة بسرعة أكبر من الصحيحة في الفضاء الرقمي، مما يعقد مهمة التصحيح والتصويب.
- صعوبة التحقق والتدقيق: فالكم الهائل من المعلومات يجعل التحقق من كل شيء أمرًا عسيرًا على الأفراد والمؤسسات.
- استغلال التقنية للربح: حيث يستغل بعض المتعالمين المنصات الرقمية للكسب المادي، مما يحفزهم على إنتاج محتوى أكثر وأقل دقة.
الفرص الواعدة
رغم التحديات، تتيح الوسائل الرقمية فرصاً ذهبية منها:
- التواصل مع الخبراء الحقيقيين: فيمكن للطالبين الوصول المباشر للمختصين الحقيقيين حول العالم والاستفادة منهم.
- تطوير أدوات التحقق: بتطوير وسائل متقدمة للتثبت من المعلومات والتأكد من مصداقيتها ومؤهلات مصادرها.
- التعلم المستمر: بإتاحة فرص لا محدودة للتعلم الصحيح من مصادر موثوقة ومتنوعة حول العالم.
من صور التعالم المعاصرة
لقد استفحلت ظاهرة التعالم في عصرنا وتعددت صورها، ومن أخطرها:
- التساهل في الفتوى: حيث يتصدر للإفتاء من لا علم له، فيحل الحرام ويحرم الحلال، متتبعًا الرخص من غير دليل، أو مجاملة للسائلين.
- التطاول على أهل العلم وتسفيه آرائهم وكأنه مجتهد مطلق.
- التعالم الإعلامي: حيث يتصدر بعضهم الفضائيات ووسائل التواصل، فيتكلمون في كل شأن ديني أو دنيوي دون تخصص أو إحاطة.
سبل مواجهة آفة التعالم
على المستوى الفردي
- تنمية الوعي النقدي: بتطوير القدرة على تمحيص المعلومات وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا من لوازم طلب العلم الصحيح.
- التحقق من المصادر: فلا يقبل المسلم معلومة قبل التأكد من مصدرها ودرجة وثوقها، عملًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾.
- الرجوع إلى أهل الاختصاص: فيطلب العلم من معادنه الأصيلة ويستفيد من خبرات المتخصصين، عملًا بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.
على المستوى المؤسسي
- تفعيل دور المراكز العلمية: بأن تتصدى الجامعات ومراكز البحث لتصحيح المفاهيم وتوعية المجتمع، وتكون منارات هداية للطالبين.
- وضع معايير للنشر العلمي: بضرورة وضع ضوابط صارمة تحكم من له حق تقديم المحتوى العلمي في الفضاء العام.
- دعم العلماء الراسخين: بتوفير المنابر لهم للوصول إلى الجمهور وتقديم المعرفة الصحيحة.
على المستوى التعليمي
- إصلاح المناهج التعليمية: بإدراج مواد البحث العلمي والتفكير النقدي في المقررات الدراسية، وتعليم الطلاب آداب طلب العلم.
- تأهيل المربين: بتدريب المعلمين على اكتشاف التعالم وتعليم الطلاب تجنبه، وغرس قيم التواضع العلمي فيهم.
- تشجيع البحث العلمي الأصيل: بإيجاد بيئة تعليمية محفزة للاستقصاء والبحث العلمي السليم المؤسس على المنهجية الصحيحة.
دور الأسرة في المواجهة
تقع على الأسرة مسؤولية جليلة في تربية النشء على القيم العلمية الصحيحة، وذلك بـ :
- غرس التواضع : بتعليم الأبناء فضيلة الاعتراف بالجهل وعدم الخجل منه، فإن هذا من أصول العلم كما قال الشعبي: “لا أدري (هي) نصف العلم”.
- تنمية حب الاستطلاع العلمي الصحيح: بتشجيع السؤال المنضبط والتوجيه نحو المصادر الموثوقة.
- القدوة الحسنة: بأن يكون الوالدان مثالاً في التعامل مع المعلومات والاعتراف بحدود معرفتهما، فالعلم رحم بين أهله.
التعالم آفة مدمرة تهدد صرح الحضارة وتقوض أسس النهضة المعرفية، وهو عتبة الدخول إلى جريمة القول على الله بغير علم التي حرمها الإسلام. ومواجهة هذا الداء تتطلب تضافر الجهود من جميع أطراف المجتمع لبناء ثقافة العلم الأصيل والتواضع المعرفي.
إن الطريق إلى مجتمع معرفي سليم يبدأ بالإقرار بأن العلم الحقيقي يحتاج إلى جهد مضنٍ وصبر جميل وتواضع جمٍّ، وأن مُدَّعِيَ المعرفة زورًا “كلابس ثوبي زور” لا يجلب إلا الضلال والإضلال.
فلنحيي سنة السلف في قولهم “لا أدري”، ولنجعلها شعارًا نفخر به، فقد قال ابن هُرْمُزَ: “يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يُوَرِّثَ جُلَسَاءَهُ مِنْ بَعْدِهِ لَا أَدْرِي، حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ أَصْلًا فِي أَيْدِيهِمْ يَفْزَعُونَ إِلَيْهِ”، ولنكن طلاب علم صادقين لا متعالمين مضلين، ولنسعَ جميعًا لإحياء روح العلم في أمتنا.
![]()
![]()