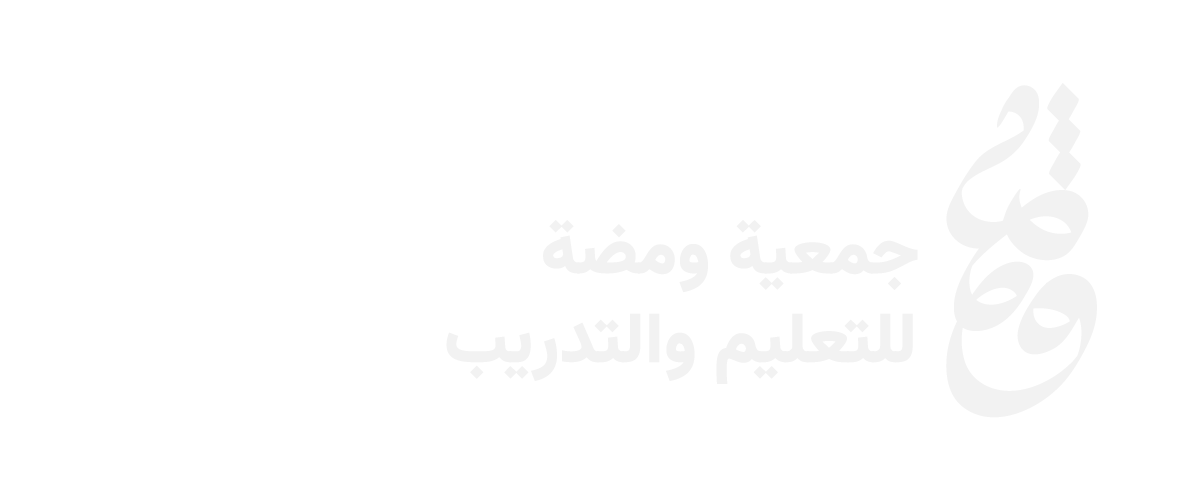من فوضى الشروح إلى فوضى المتون
من المنهجيّات التأصيلية التي تقرّرت في وسطنا العلميّ: أن يتخذ الطالب لنفسه متناً علميّاً معيّناً مختصراً ثم يطالع شرحَه أو شروحه…ثمَّ أصبحت المتونُ العلمية التي يدور عليها الطلابُ معدودةً ولكنَّ الشروحَ عديدة، فأضحى للمتن الواحدِ أكثرَ من عشرين شرحاً معاصراً، وبهذا يضيع الطالب بين الشروح ويتشتّتُ بينها، وهذا ما عايشه جيلُنا ويعايشه الجيلُ الجديدُ بصورةٍ أكبر؛ ولذلك ما زلنا نرى أسئلةَ المناهج التأصيلية ما زالت تترى ولم تتوقف بعد، مع أنَّ الإجابةَ في المتون تكاد تكون واحدةً، ولكنّ الشروح هي التي تختلف إجاباتها بحسب المجيب، وهذا لابد أن يقعَ مع تعدد الشروح واختلافها !
ولكلّ ما سبق وغيرُه- فإني أقترح أن تكون هناك منهجيةٌ أخرى، تكون جنباً إلى جنبٍ مع المنهجية السابقة، أو على الأقل يكون لهذه المنهجية حضورٌ في الوسط العلميّ، ولو كان حضوراً جانبيّاً !
وتتلخص هذه المنهجية: في الانتقال من فوضى الشروح إلى فوضى المتون، (وإنما أسميتُها فوضى من باب الإشعار بالخلل، الذي هو باعث هذه المقالة).
كما تتلخّص هذه المنهجية في اختيار متونٍ علميّةٍ عديدةٍ، ينطلق منها الطالب، ممّا أثنى عليها العلماء، ولا ضيرَ في كثرتها، فما المتونُ العلميةُ إلا فهارسُ للمسائل، ينطلق منها الطالب، فإن نقصتْ مسألةٌ من هنا أو هناك فوظيفةُ الشارح إضافتُها.
ففي هذه المنهجية ينطلق الطالب – إذا تكلَّمنا عن علم الفقهِ الحنبليّ- من الوجيز للدجيلي، وطالبٌ آخرُ ينطلق من نظمه، وثالث ينطلق من التذكرة لابن عبدوس، ورابع ينطلق من المحرر للمجد، وخامسُ من المنوّر في راجح المحرّر، وسادسٌ ينطلق من مختصر ابن تميم، وهكذا.
وبهذه المنهجيّة نتخلّص من كثرة الشروح وتعددها على المتن الواحد التي تسبّبُ التشتتَ للطالب، كما أن فيه فائدةً أخرى، وهي أننا نكتسب بها متخصصاً في كلِّ متنٍ، بدل أن يكون هناك متخصِّصون في متنٍ واحدٍ.
وفيه فائدةٌ ثالثةٌ، وهي عدم هِجران الكتب القيّمة في كلِّ علمٍ، وفيه فائدةٌ رابعةٌ وهي أنَّ هذا الطالبَ – وقد قلَّتْ الشروح بين يديه- قد لا يجد بعضَ ما يشفيه من الشرح، فيبحث ليشرح مفرداتٍ من المتن بنفسِه، فيتدرب على الشرح، فهو طالبٌ ومتدِّربٌ، بخلاف المنهجيّة الأولى التي تجعل الطالبَ جمَّاعاً ومختاراً فقط.
وما قيل في الفقه الحنبلي يقال مثلُه في بقيّة العلوم الشرعيّة واللغوية.
![]()
![]()