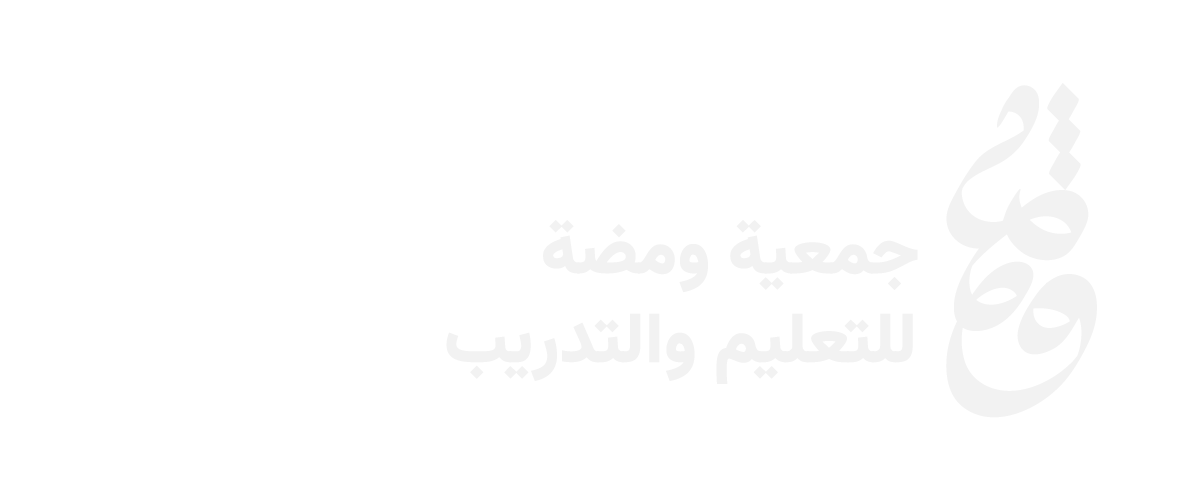من يتّصل بالبيئة العلمية، ويقترب من الميادين المعرفيّة يدرك التباين بين المنتسبين إليها، والاختلاف بين المنتمين لها في الطبائع والالتزام والاهتمام والمهارات وغيرها، و في مقال سابق تحدثت عن طالب العلم المتعجّل، وهو يمثّل واقع طائفة من المشتغلين بالعلم، وبالأخص في زمنٍ توفّرت فيه المنابر الإعلامية الشخصيّة، وفي هذا المقال نتحدث عن طائفة أخرى لا تقلّ كثرة عن الأولى، وهي طائفة شعارها غير المعلَن (التلكؤ والسير الوئيد) فإن كان الأول متعجّلا لا يدرك خطورة العجلة، متهورًا لا يدري نتيجة فعله، فإنّ الآخر عاتمٌ قد استبدّ به التريث حتى خمد، يراوح مكانه دون أن يبلغ الغاية
ويمكن تقسيم هذه الطائفة إلى قسمين:
القسم الأول: يعيش في حمى العلم، ولكن لا يشتغل به حقيقة، يدخل برامج علميّة، ويسعى لتنظيم اللقاءات والمجالس العلميّة، وحضورها، وملاحقتها، وهدفه الانضمام إلى زمرة طلاب العلم فقط. همه أن يُحصي عدد الشيوخ الذين جلس إليهم، وأن يزهو بعدد البرامج التي اشترك فيها، دون أن يكون له ثمرة تُذكر.
القسم الثاني: يعيش مع العلم حقيقة، ينهل من الكتب، ويثني الركب، ويستمع، ويدوّن، ويقرأ ويحفظ، ويتدرج في الفهم، ويترقى في التحصيل، ولا يزال هكذا دون أن يتخطى تلك الحال، فليس له أثر في ميدان الإسهام العلمي، ولم يحاول أن يصنع لبنة في بناء المعرفة!
هذه الطائفة بقسميها – مع اختلاف علميّة أصحاب كلّ قسم- يجمعهما عدم الإنجاز، وعدم استثمار القدرات خير استثمار، القسم الأول يعيش مع البرامج العلميّة دون تقدّم ملحوظ، والقسم الثاني: متمكن في طلب العلم، ولكن دون ثمرة تُرجى، وأقصد بالثمرة هنا المشاركة في صناعة المعرفة، والإسهام في نشر الوعي.
ولكلّ قسم أسباب تحتاج إلى دراسة مستفيضة؛ لنزع مسببّات التباطؤ المذموم، ولعل من أبرزها الركون إلى أدبيات شاعت بين طلاب العلم، وانتشرت مع فهم سقيم لها من مثل الصبر، وعدم الاستعجال، وأخذ العلم بتريّث وتمهّل، وهذا حقٌ ولا إشكال فيه، إنما الإشكال في معرفة مقداره، وبيان حدّه، وعلى العاقل أن يميز بين التريث المحمود والتريث المذموم، فطالب العلم الذي يمكث أضعاف ما يمكثه أقرانه في التحصيل من غير بأسٍ في ذاته، أو في مجتمعه المحيط به طالب خارجٌ عن حدّ التمهّل المحمود، وإنما يحيط نفسه بجملة من المفاهيم الخدّاعة التي يستر بها تسويفه.
وطالب العلم المتمّكن تمكنًا يؤهله للمشاركة في نشر المعرفة، ونقلها، ولكنّه يؤجل ويتردد ويرجئ فهذا أيضًا ليس في دائرة التمهّل المحمود، وقد أصبح أسيرا لعدد من المقولات التي تحوّلت إلى معتقدات يصعب – عنده -تفكيكها أو تنزيلها منزلتها ، (لا تكتب حتى تمتلك ناصية البيان، لا تتكلم حتى تتقن العلم كلّه ، لا تتسرع فالسقوط حليف التسرّع) وغيرها من المقولات التي غدت سدًّا منيعًا وحاجبًا نفسيًا يحول دون الإقدام والمشاركة.
يُقال: إنّ لعائشة بنت سعد بن أبي وقَّاص مولى اسمه فِند، وقد أرسلته ليأتيها بنارٍ فوجد قوماً يخرجون إلى مصر فخرج معهم، فأقام بها سنةً ثم قَدِم فأخذ ناراً وجاء يعدو فعثر وتبدَّد الجمر، فقال: تعست العجلة، وفيه يقول الشاعر:
ما رأينَا لِغُرابٍ مَثَلاً … إذ بَعَثْنَاه يجي بالمِشْمَلَهْ
غير فِنْدٍ أرسلوه قَابِساً … فَثوَى حَوْلاً وسَبَّ العَجَلَهْ
وهذه ليست عجلة إلا في عقل فِند، وهو مثال واضحٌ وجليٌّ خلّده التاريخ لطرافته، فالعقلاء يدركون أن صنيع فِند لا علاقة له بالعجلة، وإن المعاني لا تتغير بتغيّر مسمياتها فالفعل القبيح لا يصبح حسنا بمجرّد تغيير اسمه، وما يفعله بعض المشتغلين بالعلم هو من التسويف والضعف والبلادة، وإن سُميّت بأسماء أُخر.
إن طلب العلم ونشره من الأعمال الصالحة التي يجب المبادرة فيها، قال عمرو بن العاص: ثلاثٌ لا أناة فيهنّ: المُبادرة بالعَمل الصالح، ودَفْن الميِّت، وتَزْويج الكُفْء.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم:” نضَّر الله امرءًا سمِع مقالَتي فوعاها وحفِظها وبلَّغها فرُبَّ حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقهُ منه” وهذا الحدّ قد تجاوزه بعض طلاب العلم، وتمكنوا في مستويات عدة من العلم، ولم يشرعوا في العطاء العلمي، ومن المعلوم أن بلوغ النهاية في العلم ليس شرطًا للبدء في بذله وتعليمه.
وإن مما يغيب عن هؤلاء أنّ بذل العلم من أسباب التمكّن فيه، والتعلّم بالممارسة خير ما تُصحّح الأخطاء به.
ممارسة الكتابة، ومناقشة الأفكار، والتعرض للنقد، والتعديل والتصحيح، والعطاء بلا توقف، من أهم الأدوات التي تزيد طالب العلم معرفة وعلما.
إذا أنت لم تَزرَع وأبصرتَ حاصدًا
ندمتَ على التفريط في زَمَنِ البَذرِ
![]()
![]()