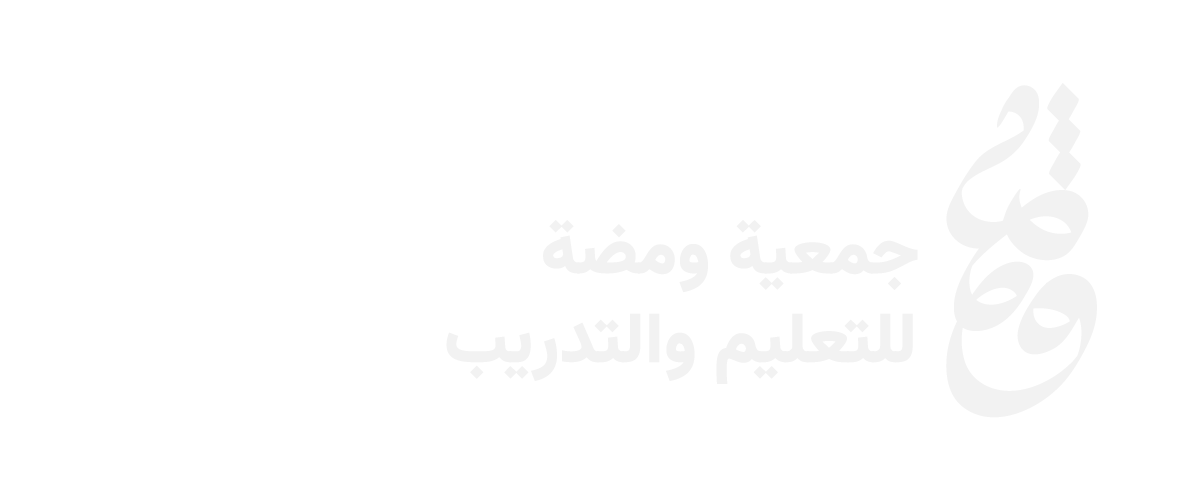حتى الكبار الذين جفّت عواطفهم يأنسون إلى الحكايا والقصص كما يأنس إليها الطفل أو أشد؛ يتبادلون الأخبار ويكررونها في المجالس من غير ملل، كأن في إعادة القصة نوعًا من استعادة الحياة نفسها، وقضاءً لشهوة الروح من داخلها؛ وكأن الكلمة تُعيد ترتيب ما بعثرته الأيام.
وشأن الملوك في ذلك معلوم لدى الصغير والكبير من أول الزمان إلى يوم الناس هذا، فما منهم من أحدٍ إلا وله راويةٌ يروي له أو مؤرخٌ يُحدّثه بما كان من قبل، وقل في النساء أضعاف ما تقول في غيرهن؛ فهنّ أحرص الناس على القصص، يتحدثن بها في اللقاءات، ويجدن فيها عزاءً عن الواقع ومتنفسًا عن الكتمان.
كل هذا يدل دلالة لا فرار منها أن حب الرواية والقصص متجذر في نفوس البشر تجذّر الغريزة في الجسد، لا يزول مع الثقافة ولا يتبدّل مع العصور، لأن الإنسان لا يكتفي بأن يعيش تجربته بل يحتاج أن يرويها ليحسّ بتمامها.
ومن هذا الميل القديم وُلدت الرواية الحديثة، فصارت مرآة للوعي لا مرآة للهوى، ومجالاً للفهم لا للتسلية،
لكن هذا لا يعني أن كل ما يُسمّى رواية يستحق أن يُقرأ؛ فكما أن في الأدب ما يسمو بالعقل، ففيه أيضاً ما يهبط به.
فالروايات الفارغة التي تُبدئ الغرائز وتُعيد الحكايات السطحية لا تُضيف إلى القارئ شيئاً؛ لأنها لا ترى في الإنسان إلا جسده أو نزواته، ولا في الحياة إلا وقائع تُروى من غير معنى، أما الرواية الحقيقية، فهي التي تكشف جوهر الإنسان في ضعفه وقوته، وتجعله يرى الحياة أوسع مما كان يظن.
وأول ما يسأل عنه القارئ الجاد؛ ما المنهج الصحيح لقراءة الرواية؟ والجواب أن الرواية لا تُقرأ بمنهج واحد، لأن كل عمل فني يفرض طريقه من داخله.
فمن الخطأ أن نقرأ جميع الروايات بعين واحدة أو بنظرية جاهزة؛ إذ هي في تعقّدها مثل الحياة، لا تُدرَك دفعةً واحدة، بل من زوايا متعدّدة؛ دينية أو نفسية أو اجتماعية أو رمزية، وكل قراءة تُضيء جانباً وتترك آخر.
الشكل الفني والمضمون القيميّ فيها وجهان لجوهرٍ واحد؛ ففكرة الرواية لا تُفهم إلا من خلال الطريقة الفنية التي اختارها المؤلف للظهور، ومن يفصل بين الشكل والمضمون يقتل روح النص.
وفي مركز الرواية تقف الشخصية، تتغيّر مع الأحداث كما يتغيّر الإنسان، وتفقد صدقها إن ظلت على حالها من بداية الرواية حتى آخرها، وكذلك تُعرف الشخصية من لغتها؛ فلكل شخصية قاموسها الذي يناسب ثقافتها ومزاجها، فلا الجاهل يحاور نفسه حوار الفلاسفة، ولا البذيء يتكلم بأدب الفضلاء، ولا الملوك يتخاطبون مخاطبة السفهاء.
ومن خلال تحليل الشخصية يتبيّن للناقد عقلها الباطن، ولا يصح أن يتوهم القارئ أنه تعبير عن روح المؤلف، بل هو دليل على وعي المؤلف بأنماط البشر المختلفة، وقدرته على خلق الشخصيات وخلق بواطنها، ثم ربط هذه البواطن بسلوكيات تناسبها ليهتدي القارئ الحصيف إلى خوافيها.
ومع هذا فلا ننفي أن تتسلّل بعض المعاني إلى النص في خفاءٍ يُعبّر عن روح المؤلف من حيث لا يعلم؛ ولكن كيف سيميز القارئ ذلك؟! فلا تقلق أيها الكاتب!.
ولا حياد في الرواية ولا في نقدها؛ فكل كتابةٍ انحياز لرؤيةٍ أو إحساسٍ بالحياة، وكل حيادٍ ظاهرٍ موقفٌ مستتر، أما الجنس في الرواية الجادة، فالأصل فيه عند كبار الكتاب أنه موضع إدانةٍ أو سقوط، لا تمجيدٍ أو تزيين؛ استخدموه لكشف الصراع بين الغريزة والضمير لا لإثارته أو التبرير له.
الرواية ليست ترفاً للفراغ ولا وسيلة للهروب من الواقع، بل أداة لفهمه، اقرأ الرواية لا لتعرف الحكاية، بل لتفهم نفسك، فالرواية الجيدة لا تسرّيك لحظة، بل تغيّرك إلى الأبد.
![]()
![]()