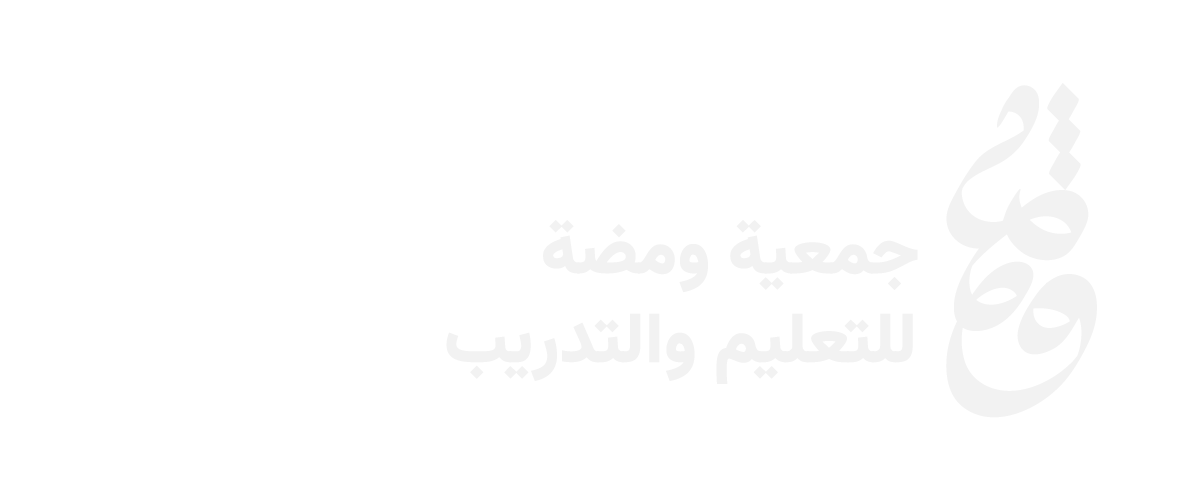لم تكن القراءة يومًا فعلًا ثقافيًا هامشيًا، بل كانت ولا تزال مدخلًا لصناعة الإنسان الواعي، وبناء العقل الراشد، وتهذيب السلوك. وقد دلّ الشرع والعقل والتجربة الإنسانية على أن القراءة ليست مجرد تحصيل معرفة، بل هي عبادة فكرية ومسؤولية حضارية.
ويكفي القراءة شرفًا أن كانت أول أمرٍ إلهي نزل به الوحي، قال الله تعالى:
﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: 1]
وهذا يدل دلالة صريحة على أن القراءة أساس الاستخلاف، وبوابة العلم، وأول خطوات بناء الإنسان المؤمن الواعي.
لقد صنعت مني القراءة عقلًا متأملًا لا يكتفي بظاهر الأمور، بل يسعى للفهم والتدبر، امتثالًا لقوله تعالى:
﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ [محمد: 24]
فالقراءة الحقيقية هي التي تقود إلى التدبر، لا إلى التكديس المعرفي، وتنتج إنسانًا يُحسن الفهم قبل إصدار الأحكام.
كما صنعت مني القراءة اتزانًا نفسيًا وسعة صدر، إذ كلما اطّلعت على تجارب البشر، أدركت اختلافهم وتنوعهم، فخفّ اندفاعي، وزاد تفهّمي. وهذا المعنى تؤكده السنة النبوية، إذ قال النبي ﷺ:
«إنما العلم بالتعلُّم، وإنما الحِلم بالتحلُّم»
(رواه الطبراني وحسنه الألباني)
فالقراءة باب من أبواب التعلّم، ومن ثَمّ باب لاكتساب الحِلم والرزانة.
ومن أعظم ما غرسته القراءة في النفس، تعظيم العلم وأهله، قال تعالى:
﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: 9]
فالقراءة ليست مساوية لبقية العادات، بل ترفع صاحبها درجة في الفهم والبصيرة، وتجعله أكثر وعيًا بواقعه ومسؤوليته.
كما أسهمت القراءة في بناء لغة راقية وأسلوب متزن، فاللسان مرآة الفكر، والفكر يتغذى مما نقرأ. وقد قال ﷺ:
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»
(متفق عليه)
ولا يُحسن الإنسان قول الخير إلا إذا امتلأ عقله بمعرفة راشدة وقراءة واعية.
أما الأثر الأعمق للقراءة، فهو أنها تزرع التواضع العلمي، فكلما ازداد الإنسان قراءة، ازداد إدراكًا لحدود علمه، مصداقًا لقول الله تعالى:
﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 85]
فتنشأ نفس متعلّمة لا متعالية، وباحثة لا مدّعية.
ختاما
القراءة ليست وسيلة للثقافة فحسب، بل طريق لصناعة الإنسان المتوازن: عقلًا، ونفسًا، ولسانًا، وسلوكًا. وهي جسر يصل بين الوحي والعقل، وبين العلم والعمل، وبين المعرفة والأثر.
![]()
![]()