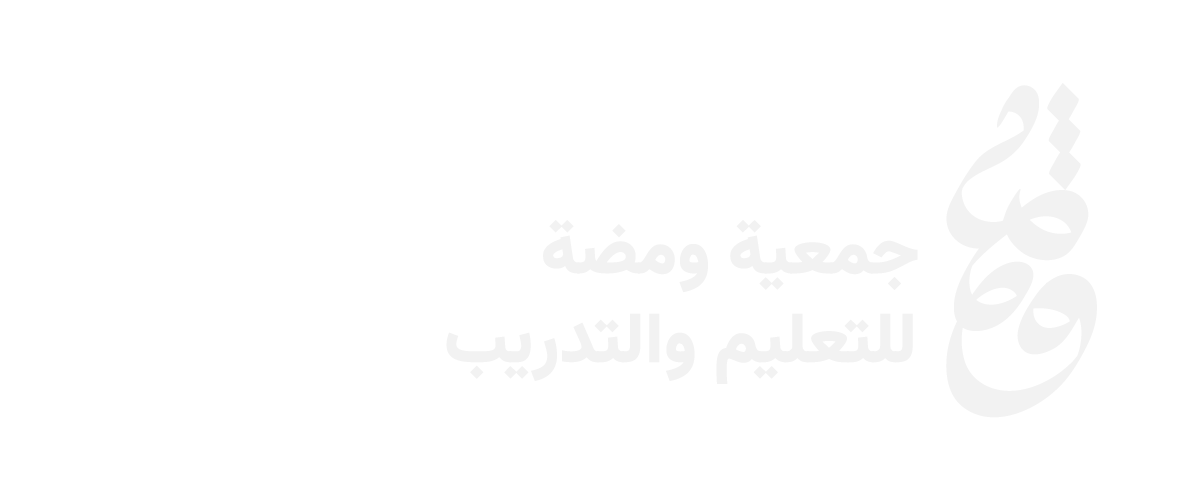قيل للصاحب بن عباد: ما أحسن السجع؟ قال: ما خفّ على السمع، قيل: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا!
هذه طريقة طريفة في الإفادة، يمتزج فيه التنظير بالتطبيق، ولذا أحسب أنها أسلوب تعليمي لا يُعلى عليه في سرعة استجابة المتعلم له، واستيعابه لمضمونه، وثباته في ذاكرته، وما استجمع كل هذه المزايا إلا لما فيه من مفاجأة المتلقي وبراعة المتكلم وإيجاز الطريقة، وغالباً ما يأتي عفوَ الخاطر، لا يتقصده المتكلم إلا بعد أن يُصادفه دون سابق مواعدة، فيعطيه مقادته دون ممانعة.
وهي طريقة لا يفطن لها ولا يقدر عليها إلا الحُذّاق الأفذاذ، ممن تعيش الأفكار في عقولهم فيأنسون بها وتأنس بهم، فتطاوعهم متى ما أرادوا توظيفها في سياقها الصحيح، ممن أمثال شيخنا الدكتور محمد أبو موسى فهو ممن يحسن هذا الطريقة، ويوظف المعلومة في سياقها بحذق ومهارة!
ففي (خصائص التراكيب) عند تعداده لمزايا تعريف المسند إليه باسم الإشارة، ذكر أنّ “من أبرز مزايا أسماء الإشارة أنها تعين المتكلم على التركيز والإيجاز، وتفادي التكرار الذي يترهل به الأساليب، ويتثاقل به وثوبها إلى القلوب، فقد تجد الباحث يعرض المسألة بتفاصيلها، ثم يحتاج إلى إضافة قيد أو ما يشبهه مما يعوزه إلى الإعادة، وحينئذٍ تسعفه أسماء الإشارة، فيسلك سبيلاً غير سبيل التكرار، ولست في حاجة إلى أن أذكر لك شاهداً على “ذلك” من الكتب، وانظر إلى اسم الإشارة في قولي: على ذلك، تجد الشاهد”.
وفي (التصوير البياني) بعد تحليله لأمثلة تلتبس فيها الاستعارة المكنية بالتشبيه الذي يضاف فيه المشبه به إلى المشبه علق بقوله: “وهكذا يهديك التأمل في الصور والتعرف على معانيها إلى الوجه الذي تستقيم عليه من ضروب البيان، فقد رأينا في التراكيب التي جاءت على طريق الإضافة ما هو من قبيل التشبيه، وما هو من قبيل الحقيقة .. والمهم أنّ هذه الصور يفسدها التكلف والتعمق؛ لأنها “بنات القلب والروح”، فلا ينبغي أن تؤخذ إلا من الوجه الميسور”، والشاهد في قوله: بنات القلب والروح!
وفي موضع آخر عند تحليله الماتع لكلام عبد القاهر حول الوشائح التي خوّلت إطلاق الإصبع على الأثر الخاص، علّق بقوله : “وقد تكلّم الشريف الرضيّ في إطلاق الإصبع على الأثر، وكان عبد القاهر اطلع على ذلك، ولكنه كعادته فيما بين يديه من جهود العلماء لا يدعها من غير أن “يترك فيه إصبعه””.
وأكتفي بموضع واحدٍ لعبد القاهر الجرجاني، بناءً على أنه ملهم أبو موسى هذه الطريقة، وأنه مثالُها من بُعدها الأعمّ، حيث كان يؤسس للبلاغة ببلاغة، ويحلّل الشعر العالي بلغة عالية، ويضبط القاعدة بضبط العبارة، وكان ذلك الموضع حين كان يحلل مزايا التمثيل وآثاره الحسنى على النفوس، وبالتحديد عند مزية إيجاد الائتلاف بين المختلفات، قال : “ولم تأتلف هذه الأجناس المختلفة للممثّل، ولم “تتصادف” هذه الأشياء “المتعادية” على حُكم المشبه، إلا لأنه لم يُراع ما يحضر العين، ولكن ما يستحضر العقل”.
هكذا في نسخة محمود شاكر، ولا شاهد فيها، والأولى ببيان عبد القاهر ما صحّحه المراغي في نسخته، من أنّ الصواب: “لم تتصاف” من المصافاة بدل “لم تتصادف”؛ ليتحقق التضاد والانسجام بين الفكرة وأسلوب التعبير عنها!
إن هذا التمثّل الآني للفكرة يعمّق الاتصال بين التنظير والتطبيق، حيث يكون السياق واحداً، ويؤكّد المعنى حيث يكون المنظّر للفكرة هو المطبّق لها، ويفاجئ المتلقي من حيث لا يحتسب، فلا جرم أن يقع المثال من نفسه موقعه الحسن؛ إذ مبنى الطباع وموضوع الجبلة على أنّ الشيء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه، وخرج من معدن ليس بمعدن له، كانت صبابة النفوس به أكثر، وكان الشغف له أجدر، كما يقول عبد القاهر الجرجاني، فوق ما يطمع هذا الأسلوب المتلقي من اقتحام التجربة من فورها، وتمثّل المعلومة تمثّلاً صادقاً قوامه الانفعال بها، وسرعة الاستجابة لأثرها!
![]()
![]()