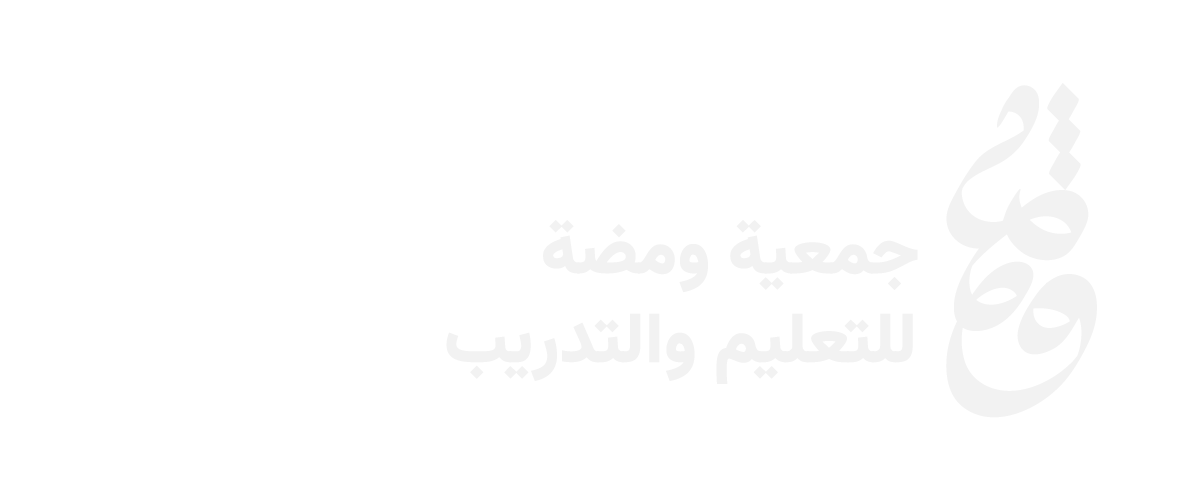يُعَدُّ العمل التطوعي في المجتمعات الإنسانية خيطًا ذهبيًا يربط بين أفرادها، ويعزز مجموعة من المبادئ العالية من البذل والتكافل والرحمة، فهو تجسيدٌ للقيم الإنسانية الرفيعة، وترجمةٌ عمليةٌ للإيثار والعطاء، ولكن قد تشوّه هذه الصورة النبيلة والجميلة بعضُ الممارسات الفردية المبنيّة على فهم خاطئ، واعتقاد غير رشيد، هذا الفهم – من وجهة نظري- من أهم أسباب القصور في العمل، وهو الاحتجاج بالتفضّل، فالعمل ما دام تطوعًا، أي بلا مقابل مادي، فإنه يقبل التهاون والتسويف، ويُعفَى صاحبه من مسؤولية الإتقان والجودة، ويَستدل بعضُ هؤلاء عند مواجهتهم، ومحاسبتهم على تقصيرهم بقوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾، فمجرد انخراطهم في العمل دون مقابل يضعهم- وفق اعتقادهم- في مصاف “المحسنين” الذين رُفع عنهم الحرج واللوم.
وهذه المقالة تسعى لدفع هذه الشبهة انطلاقًا من أنّ كلّ عملٍ يلتزم به المرء، سواء كان بأجرٍ أم بغير أجر، هو أمانةٌ في عنقه، وعهدٌ يجب الوفاء به على أكمل وجه.
دعونا نتأمل في الآية المستدّل بها، وهي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (التوبة: 91)، نجد أن السياقَ بعيدٌ كلّ البعد عن تبرير الإهمال، فإن الآية تتحدث عن فئاتٍ مخصوصةٍ من الناس، وهم أصحاب الأعذار الحقيقية المانعة من أداء المهمة مثل: المرضى والضعفاء والفقراء الذين لا يملكون نفقة الخروج، فالحرج مرفوعٌ عنهم بشرط، وهو: “إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ”. والنصح هنا يشمل صدق النية، ورغبتهم الصادقة في المشاركة لو زال المانع، وتقديمهم ما يستطيعون، فالآية إذن ترفع الحرج عن العجز عن الأداء، لا عن التقصير في الأداء، وهناك فرقٌ شاسع بين من لا يستطيع القيام بالعمل أصلًا، ومن قَبِلَ بالعمل ثم أهمله، أو أدى العمل وقد قدّم كل إمكانياته، وبذل كل ما يستطيعه.
يقول السعدي” وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه، سقط عنه ما لا يقدر عليه” فـ “الإحسان” هنا هو بذل الجهد الكامل والحرص التام، فإذا قام متطوع بعمله بكل حرص وإتقان، ثم وقع ضرر من غير إرادة ولا تسبب، فلا سبيل عليه، أما إن كان سبب الضرر هو تفريطه وتقصيره، فقد خرج من دائرة “المحسنين” إلى دائرة “المسيئين”.
إذن الاستدلال بالآية على إباحة التقصير في العمل التطوعي هو قلبٌ للحقيقة، وتحويلها من رخصة للعاجز إلى حجة للمُقصِّر.
ثم كيف نتمسّك بتأويل بعيد لآية، ونترك نصوصًا شرعيةً مستفيضة تحثّ على أداء الأمانة، ووجوب الإتقان، ويتجلى هذا المعنى بوضوحٍ في قوله عليه الصلاة والسلام: “إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكمْ عملًا أنْ يُتقِنَهُ”. فربطُ الإتقان بمحبة الله هو أعظم حافزٍ للمؤمن. فهل يتصور عاقل أن محبة الله تُنال في إتقان العمل المأجور، وتُهمل في العمل التطوعي الذي هو أقرب إلى القُربى والعبادة؟
عندما يقدُم شخصٌ على عمل تطوعي، فإنه لا ينبغي له الاقتصار على الفضلة من الوقت أو الجهد يختار مقدارهما وتوقيتهما بحسب ما تيسر له، لا بحسب ما يقدّم العمل بصورته النموذجية، بل عليه أن يدرك أنّه يقدّم عهدًا وكلمة، وبقبول المهمة، تتحول من نافلةٍ إلى أمانةٍ في عنقه، ويصبح مسؤولًا عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسؤولٌ عن رعيتهِ فالأميرُ الذي على الناسِ راعٍ عليهم وهو مسؤولٌ عنهم والرجلُ راعٍ على أهلِ بيتِهِ وهو مسؤولٌ عنهم والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ بعلها وولدِهِ وهي مسؤولةٌ عنهم وعبدُ الرجلِ راعٍ على بيتِ سيدِهِ وهو مسؤولٌ عنهُ ألا فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيتِهِ”. فالمتطوع الذي قَبِل القيام بمهمة معينة، صار راعيًا لها، وهو مسؤولٌ أمام الله، وأمام الجهة التي تطوع فيها، والمستفيدين من عمله، عن إتمام هذه الرعاية على الوجه الأكمل.
إن الإهمال في العمل التطوعي خيانة لهذه الأمانة، والآثار المترتبة عليه قد تكون وخيمة؛ فالمعلومات التي يُدخلها متطوع بغير دقة قد تتسبب في حرمان مستحق، والمشروع الذي يتأخر في إنجازه قد يُفوِّت فرصة ثمينة على المستفيدين، والدرس الذي لا يُحضِّر له المعلم المتطوع جيدًا يضيع وقت الطلاب ويقتل شغفهم.
ولا أبالغ لو قلت الضرر الناتج عن إهمال المتطوع قد يفوق الضرر الناتج عن إهمال الموظف المأجور، لأن المؤسسات التطوعية غالبًا ما تعمل بموارد محدودة، وتعتمد بشكل كلي على جودة عطاء متطوعيها.
وما أزعجني قولٌ في الأعمال التطوعية كقول القائل: “أنا متطوع، وهذا فضلٌ مني”. نعم أخي المتطوّع، هو فضلٌ منك أن تعرض خدمتك، ولكن حين تقبل المهمة، يتحول الفضل إلى واجب، وتصبح مُلزمًا بالإتقان.
ثم أين الهمة العالية والطموح الذي لا يرضى بالدون؟! وأين استشعار أنّ ما تقدمه من عمل تطوعي فيه فرصة لإعمار الأرض وتحقيق العبودية، كما قال تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾. وهذه المهمة العظيمة لا تليق بها الأعمال المتواضعة والجهود القاصرة. إنها تتطلب همةً عالية
إِذا غامَرتَ في شَرَفٍ مَرومٍ … فَلا تَقنَع بِما دونَ النُجومِ
فَطَعمُ المَوتِ في أَمرٍ صَغيرٍ … كَطَعمِ المَوتِ في أَمرٍ عَظيمِ
فلتكن أعمالنا التطوعية مساعٍ جادّة في شرف خدمة الخلق، فلا نقنع فيها إلا بأعلى درجات الجودة والإتقان، وإن التقصير في عمل تطوعي “صغير” هو فشلٌ يعكس حالة من التراخي واللامبالاة في شخصية الإنسان، وهو الفشل ذاته الذي قد يصيبه في أمر “عظيم”؛ لأن الروح التي تقبل بالدون في أمر، ستقبل به في الأمور كلّها.
وأختم بتذكير بفكرة المقالة، إنّ الآية الكريمة ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ ليست درعًا يحتمي به المُقصِّر، وإنما هي عذرٌ، ورفع حرجٍ عمّن بذل قصارى جهده، وأخلص نيته، ثم سلَّم أمره لمن لا يضيّع أجر من أحسن عملًا.
![]()
![]()