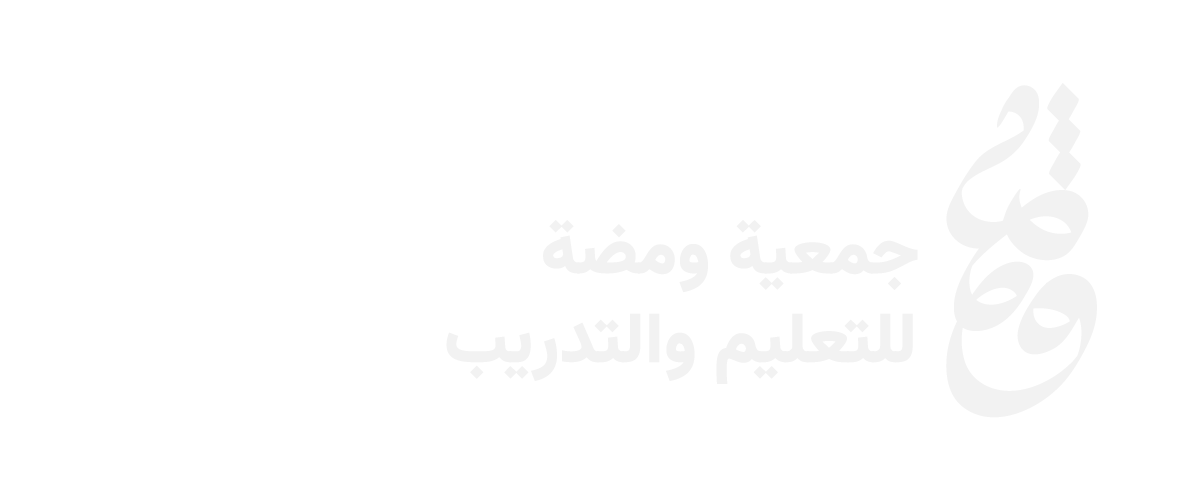الترقي الفكري وتحولاته المعرفية
من الأمور الاعتيادية في الترقي المعرفي التي درج عليه الباحث وهو يمتد في أفق المعرفة العريض، اتساع الرؤية الفكرية لديه واحتذاء المنهج القويم الذي محصته الخبرة واستوثقت أركانه ومآلاته حصافة السنين، فتجد الباحث قد أستوفى الأصول المعرفية في الفرع العلمي التخصصي وأطاف في مسائله وعرف مضايقه و استحكم عرى أبوابه وفصوله ، وهنا يبلغ العالم مرحلة النضج والاستواء المعرفي الذي يعقبه مرحلة الاجتهاد و جني والحصاد، فيضيف لبنته المرجوة في تشيد صرح هذا العلم وبنائه ليتمكن من مسايرة ومواكبة مستجدات الحياة ومقتضياتها وحيثياتها المعرفية ، ومن هنا يمكن تدوين مسيرة هذا العالم/ الباحث في سجل التاريخ الحافل بالمنجز والابتكار. بعد أن كانت تستثقله منعرجات المسائل وعويصات تفريعاتها.
هذه هو الشأن الطبيعي في بناء العلوم والمعارف وتشييدها…وربما صادف هذا الترقي ضربا من الإشكال المعرفي الذي يواجهه الباحثون ورواد المعرفة أثناء سيرهم في الاستقصاء العلمي وما تحدثه – عادة – طبيعة التطورات التلقائية والارتقاء الفكري والتعمق في بحار المعرفة التي من شأنها أن تغوص بالباحث في أعماق متناهية أو تحلق به في فضاءات علمية مترامية الأرجاء يفرضها عليه الانفتاح الهائل والواقع المعرفي المستجد فيحدث بسببه بعض التحولات المنهجية والتغير في مسارات التعاطي الفكري والمعرفي في هذا التطور والترقي، وربما ينعطف المسار أحيانا بهذه التحولات نحو الاتجاه المعاكس في التعاطي مع مسائل العلم والفكر والمثاقفة التي استقرت عليها الأصول والمنطلقات لهذا الفرع من العلم ، فيبدأ بنقض ما كان يترسخ لديه وهذه الإشكالية في تصوري لها وجهان ليسا من عملة واحدة ، وهما مكمن الخلط واللبس،
وجه: يمثل طبيعة التطورات والارتيادات لعوالم المعرفة ، وتغير الأحوال والملابسات التي تجري وتجدّ في الساحة المعرفية ، والتحولات الكبرى الى تشهدها الحركة العلمية والفكرية في واقعها ومأمولها . وهذا التغيير هو من طبيعة النمو المعرفي التي تفرضه قوانين الحياة وطبيعتها ، فهو من مسوغات الفكر والعقل وهو متسق منهجيا، بل ومطلوب الأخذ به و إذا ما أردنا الاجتهاد وكسر الأغلال والقيود التي تحد من حركة العلم ونمائه كلما اتجه نحو آفاق التجدد والمواكبة والمعاصرة ؛ لأنه يمثل مرتبة من مراتب الترقي والتجدد وسلماً من سلالم الوصول نحو الغايات والمقاصد.
والوجه الآخر: يمثل التغير المعرفي النكوصي – إن جاز الوصف – ، وتبني منهجية مختلفة من شأنها أن تحرف المسار وتبدل أفق الرؤيا وتغيّب المقصد تماما الذي من أجله شق الطريق .والإشكالية في نظري تكمن في عملية الخلط بينهما أو محاولة التلبيس بين هذين المسارين المتباينين فضيلة الاجتهاد والتطور والاستيعاب للواقع الحضاري والمعرفي ، وبين الارتداد والتنكب عن المنهج العلمي والفكري ومحاولة اختصار المسافة والارتماء في أحضان المناهج المبسترة التي من شأنها أن تمحو آثار الطريق وتحجب أفق الرؤيا المعرفية المتأصلة والغاية المقصدية المنشودة وتضعف المناعة الثقافية والانتمائية . فتقف بذلك عجلة الاجتهاد وتضيق السبل والأسباب الداعية لتمدد هذا العلم ونمائه وتضعف الشخصية العلمية وهويته . من هنا وجب التفريق بين الوجهين في انتهاج الطريق . وفي ظني أن الضابط لهذه المسألة، هو النظر في الأفق الذي ينشده المتحول والأسباب الداعية لهذا التغير ، فمتى ما تحولت معه الرؤيا الفلسفية والغاية التي يتقصدها من أجل الامتداد بمسائل وفروع العلم، وتشكلت لديه مفاهيم ومنطلقات وقناعات جديدة تناقض الأصول التي رسمت وحددت معالم وملامح هذا الفرع المعرفي بأي شكل من الأشكال، فظني أن الإشكال سيقع هنا وسيظل قائما .. وأن محاولة الاجتهاد بالتضام والتآخي بهذه الأقوال والأصول المنهجية لن يخلوا من تناقض أو تضاد . أما إذا بقيت تلك الرؤيا المنهجية في أصول العلم قائمة وامتدَّ بها إلى أفق أرحب يستدعيها الموقف المعرفي ويقتضيها الواقع الفكري والحضاري دون هزِّ للثوابت الأصولية ودون مخالفة للمقاصد الكبرى التي يتغيا إليها هذا العلم، فإن المسألة تختلف، وشتان ما بينهما .وأظن أن باعث هذه الإشكالات في هذه التحولات لا تنشأ وليدة لحظة فارقة وإنما تطرأ بشكل تدريجي إذا لم يتعهدها الباحث ويرسم منهجا واضحا لشخصيته العلمية وهويته الثقافية والفكرية من تلك البواعث أن يمكن أن نجملها في نقاط :
-ضبابية المقاصد الكبرى في الرؤية الفلسفية للعلم ..وربما ضعف الوازع الأخلاصي في طلب العلم.
-الفصل بين الموقف الفكري الحضاري الممثل للهوية الانتمائية والواقع المعرفي المفروض ، والاستجابة لمؤثرات المراحل وضغط التيارات الفكرية السائدة التي امتلكت سطوة البريق والنفوذ والإغراء .
-استسهال التغير والتحويل بحاجة وبدون حاجة وعدم رسم موقف له ملامح واضحة ومحددة في خطى التقدم والاجتهاد العلمي المنشود .
-السعي وراء المراكز والمناصب القيادية الروتينية التي من شأنها أن تذيب الأصول المنهجية والفكرية ولا تتبنى رؤية علمية واضحة، وتتساهل بشكل مفرط في هزّ الثوابت والأصول الفكرية بوعي وبدون وعي.
-ضعف الوازع الثقافي الانتمائي وعدم رسوخ الهوية القومية
-ضعف الاجتهاد وخفوت روح المثابرة والشعور بالعجز والجمود وعدم القدرة على تحريك مسائل العلم التراثية وفتح مسارات وارتياد مساحات بكر في فصولها ومعاقدها تعيد وهج البريق المعرفي والريادة الثقافية .
-الاعتماد على المترجمات والمنجزات الغربية دون وعي وفهم المسائل التراث واستقصائه.
-هاجس الإتيان بالجديد المختلف في عالم الأبحاث والمعرفة. وهو هاجس لا ينفك عن الباحث الطامح للتميز ، وهو هدف مشروع وغاية سامية تستحق العناء والتوسع في البحث وبذل ما في الوسع والتروي من أجلها في التوخي وحسن الاختيار، لكن جعل عنصر الجدة والمغايرة والاختلاف هي المقصد وأم الغايات دون ربطها بغاية نفعية حقيقية تضيف للمعرفة وتقبل التطبيق والتنزيل على أرض الواقع ويستسيغها المنطق العام ومنطق المادة العلمية المطروقة والموقف الحضاري ، يجعل من فكرة البحث العلمى والتجديد فكرة موازية لفكرة الموضى والبحث عن الأضواء وعالم الشهرة.
![]()
![]()