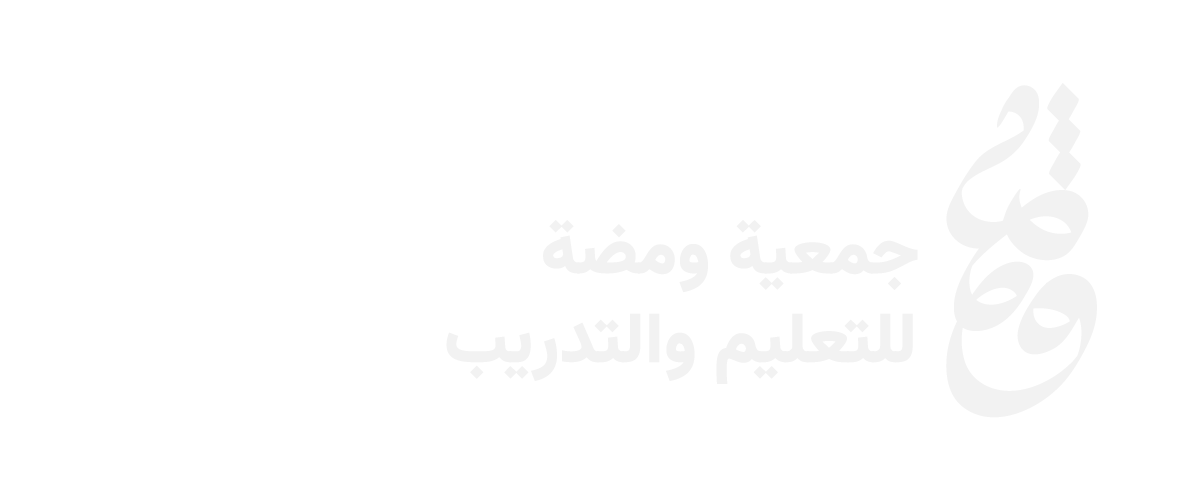يَطرَحُ بعض العاملين تساؤلًا ويحفّه شيءٌ من الحنقِ والأسفِ: لِمَ تتكرَّرُ المشاريعُ العلميةُ والمبادرات المعرفية؟ لماذا نُعيدُ ما بُدِئَ به من قبل ونكرر المكرر؟
وكأنَّ في الاقتداءِ نَقصًا، وفي المُحاكاةِ عَجزًا!
أسئلة تترددُ في فضاءاتِ العملِ العلمي، تحمل في طياتها حرصًا ظاهرًا على التجديد، ولكنها تُبطِنُ فهمًا قاصرًا لسننِ الانتشار والتأثير، فالتاريخ ينبِئُ بخلافِ ما يراهُ النَّظرُ العَجُولُ؛ فالحاجةُ ماسَّةٌ إلى مشاريعَ رائدةٍ قابلةٍ للاستنباتِ في أراضٍ جديدة؛ لأن المَقصَدَ الأسمى هو اتِّساعُ دوائرِ الخيرِ وعُمومُ النَّفعِ، لا التفاخرُ بفرادةِ البَصمةِ، أو الاحتفاءُ بسبقٍ شكليٍّ عابر، فالمشاريع الرائدة مناراتٌ تُبنَى على السواحل لتهدي السُّفُن، وليس من المقبول أن نتركَ السواحلَ الأُخرى في ظلامٍ بحجةِ أنَّ تصميمَ المنارةِ قد استُخدِمَ من قبل، وعلينا أن نفكّر ونبدع!
إنَّ المشروعَ النَّافعَ إذا أُنشِئَ على أُسُسٍ متينة هو بمثابةِ البذرةِ المباركةِ التي أُودِعَت في أرضٍ طيبة، وهذه البذرة تحمل في جوفها سرَّ النَّماء والبركة الذي أودعه الله فيها، فإذا بآخرينَ يأخذونَ من ثمرِها ليغرسوهُ في تُربَةٍ أُخرى، فتتحوَّلُ البذرةُ الواحدةُ إلى حقولٍ وبساتين.
ومن هنا، كان الفرحُ باتِّساعِ أثرِ العملِ الصالحِ أَوْلى من التَّبرُّمِ بتكرارِ صورته، فالعاملُ الصَّادقُ يغمرهُ السُّرورُ حين يرى مشروعَه يُقتَبَسُ في بيئةٍ أُخرى، لأن الغايةَ واحدة: خدمةُ دينِ الله، ونفعُ عبادِه، وتحصينُ الأجيال، ، ولا شكّ أن فرحَ المُؤسِّسِ الأول بامتداد أثر عمله هو علامةُ صدقٍ وإخلاص، ودليلٌ على أن مقصده كان وجهَ الله، لا أن يُقال: “هذا عملُ فلان”، بل عليه أن يتجاوزَ الاقتصار على الشعورِ إلى تذليلِ العقبات، وتيسيرِ الاقتباسِ، ودعمِ الراغبين في استنساخِ مشروعه بما ستطيعه من وسائلِ الدعم، يقولِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ». تأمَّل ” سنّة حسنة” بهذا القيد فقط، فهي لا تعني اختراعًا من العدم، بل قد تكون إحياءً لسنة، أو تأسيسًا لمنهجية، أو بناءً لمشروعٍ يُحتذى به، أو تطبيق مشروعٍ في بيئاتٍ أخرى، المهم أن تكونَ حسنةً.
وليس في هذا دعوةٌ إلى تعطيلِ العقولِ عن الإبداع، أو قتلِ روحِ الابتكار، بل هي دعوةٌ إلى أن يُبنى على القائم ويُستثمَرَ النَّاجح، دون اقتباسٍ أعمى، أو تقليدٍ مذمومٍ، ومن المعلوم أن قيامَ المشروعِ ليس دليلًا على صلاحه، وإذا كان صالحًا في بيئة قد لا يكون مناسبًا في بيئات أخرى، وكلّ هذا يجب أن يكون حاضرًا عند اختيار المشاريع النوعيّة، ولا بد من وضع معايير لهذه العملية، فالمشروع الجدير بالمحاكاة هو “المشروع النوعي” الذي يُقاس نجاحه بخصائص جوهرية تضمن أثره وعمقه، المشروع الذي وُلد ليلبي احتياجات، ويحل إشكالات حقيقية قائمة، وهو مشروعٌ مصمم ليُحدث أثرًا حقيقيًا ومستدامًا يمكن قياسه، ومن أهم ما يميز هذه المشاريع الرائدة أنها تحمل في طياتها القابلية للتوسع والانتشار.
هذا وإنّ الاقتباسَ الحسنَ ينطلق من عملية مركبة من: فهم جوهر المشروع، وضرورة تكييفه، ومحاولة إضافة اللمسة الخاصة، فعلى أصحاب المشاريع أولًا فهمَ جوهرِ نجاحِ المشروع الأصلي، ثم يُكيِّفُ أدواته لتناسبَ بيئتَه الخاصة، ثم يُضيفُ من فكره وتجربته ما يجعله أكثر نفعًا وإثمارًا، فيكون كمن أخذ شعلةً من نارٍ متقدة، وليس غايته اللهبَ ذاته، بل ليُوقدَ بها مصباحَه الخاص الذي يُضيءُ مسيره.
دعونا ننتقل إلى جانب آخر غاية في الأهمية، وهي الفائدة على المشروع ذاته، فهل في اقتباس المشروع نفعٌ على المشروع نفسه؟
الجواب نعم، فتطبيق المشروع من عقول متعددة، وفي بيئات مختلفة لمستفيدين آخرين من شأنه زيادة فرص التحسين، بعد امتحانه وفق ظروف مختلفة ومتنوعة، وهو أدعى للتجويد والتطوير.
فحريٌّ بالعاملين في ميادينِ العلمِ والتربيةِ ألا يأنفوا من محاكاةِ برنامجٍ ناجح، وألا يزهدوا في تكرارِ فكرةٍ نافعة، فإن هذا من أعظم صور التعاون على الخير الذي أمرَ اللهُ به فقال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: 2]. إنَّ الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى استنساخ نماذجها المشرقة في كلِّ مكان، فبدلًا من أن يضيع الجهد في ألف محاولةٍ فاشلة لابتكار العجلة، فلتُؤخذ أفضل النماذج الناجحة، وليُعقد العزم على تطويرها وتجويدها.
المهمُّ أن تَصِحَّ النيَّةُ، ويُخلَصَ القصدُ، وتُضافَ إلى كلِّ نسخةٍ بصمةُ تطويرٍ أو لمسةُ تحسينٍ تناسبُ ظروفَ الزمانِ والمكان.
والمشاريعُ المتميزةُ إذا بقيت يتيمةً في موطنها، سرعان ما يطويها النسيان، تمرض بمرض القائم عليها، وتموت بموته، وأمَّا إذا تكاثرت وتوالدت، فتصنعُ تيارًا قويًّا من الوعي والخير. وتمكّن صاحبَها الأولَ من أثرٍ لا يَموت، وعُمرٍ ثانٍ بعد رحيله، كما قال الشاعر:
دَقَّاتُ قَلْبِ المَرْءِ قَائِلَةٌ لَهُ … إِنَّ الحَيَاةَ دَقَائِقٌ وَثَوَانِي
فَارْفَعْ لِنَفْسِكَ بَعْدَ مَوْتِكَ ذِكْرَهَا … فَالذِّكْرُ لِلْإِنْسَانِ عُمْرٌ ثَانِ
![]()
![]()