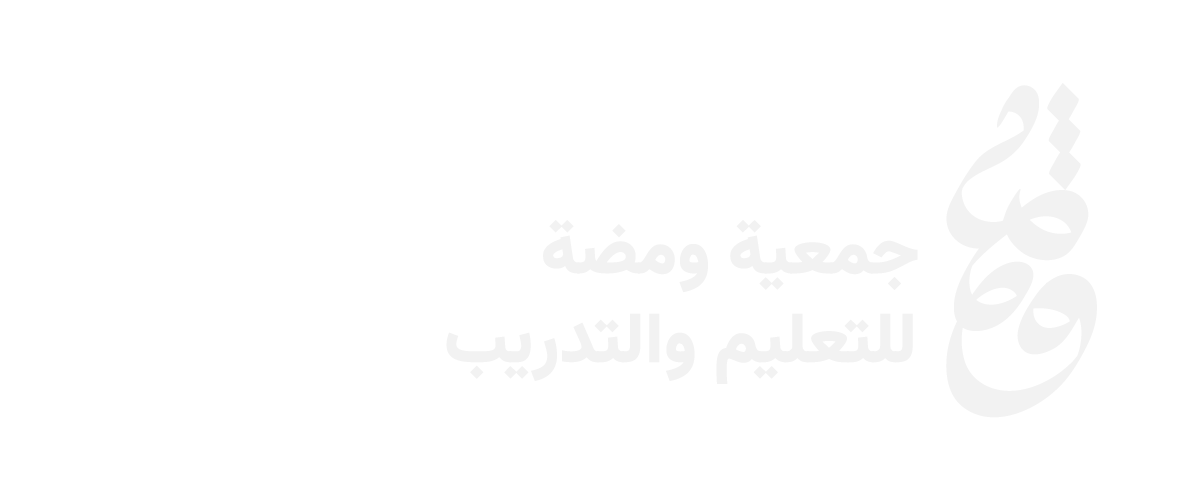شاعت في زماننا مقولة “اللغة العربية لغةٌ معقّدةٌ عسيرةٌ، يَشِقُّ على المتعلّم إتقانُها”
وغدت عند كثيرٍ من الناس من المُسلَّمات التي لا تُناقش، والبداهة التي لا يُشك فيها، وبات من يُعارض هذه المقولة أو يُشكّك فيها يُنظر إليه بعين الريبة: إمّا جاهلٌ بحقيقة اللغات، أو متعصّبٌ للعربية بغير وجه حقّ، يدفعه الحماس والعاطفة لا العلم والموضوعية!
وهذه المقولة – على شيوعها وذيوعها – دعوى تفتقر إلى الدليل العلمي، قائمة في أحسن أحوالها – إذا استبعدنا التحيّز والأهواء عن أصحابها – على انطباعات شخصية لا ترقى إلى مرتبة الحقائق، وعلى تجارب فردية محدودة لا تصلح أساسًا للتعميم.
فكيف صارت هذه الانطباعات حقيقة مطلقة؟
وبأيّ ميزانٍ عِلميٍّ قِيست صعوبة اللغات؟
قبل الحكم على لغةٍ ما بالسهولة أو الصعوبة، لا بدّ من التأمّل في حقيقة مهمّة: عملية تعليم اللغات، وهي عمليةٌ معقّدةٌ مركّبة، تتداخل فيه عواملُ شتى، يُؤثّر بعضها في بعض، وتختلط اختلاطًا يخيل للناظر فيها أنّها شيئًا واحدًا، ويصعب فصل مكوناتها وتمييزها.
من هذه العوامل المتشابكة المؤثرة:
أولاً: المتعلّم نفسه
ثقافته اللغوية الأولى (اللغة الأم)، وقدراته الذهنية واستعداداته الفطرية، ودوافعه وحوافزه النفسية، والبيئة اللغوية التي تحيط أيمارس تلك أم لا يسمعها إلا في قاعة الدرس؟
ثانيًا: المعلّم
كفاءته العلمية وقدرته التربوية، وطريقته في التدريس وأسلوبه في التواصل، وقدرته على تحبيب اللغة إلى نفوس المتعلمين.
ثالثًا: مناهج التعليم
جودة المنهج وملاءمته لمستوى المتعلمين، والتوازن بين النظري والتطبيقي، واستعمال الوسائل الحديثة والتقنيات المعينة.
رابعًا: الغاية من التعلّم
فرق بين التعلّم من أجل إتقان اللغة بعمق والاتّصال بالنصوص العربية الفصيحة، والتعلّم من أجل الاكتفاء بالتواصل اليومي العامي، ولكلٍّ أسلوب، ومنهج، وأدوات.
خامسًا: النظام التعليمي
الوقت المخصص لتعليم اللغة، وجدية المؤسسة التعليمية في تدريسها، والإمكانات المادية والبشرية المتاحة.
فإذا اختلّ عاملٌ من هذه العوامل – أو أكثر – فشل التعليم أو ضعف، سواء أكانت اللغة المُراد تعلّمها عربية أم إنجليزية أم صينية. فالمشكلة ليست في اللغة نفسها، بل في منظومة التعليم بكلّ عناصرها، ومتى سقط عمادٌ من هذه الأعمدة، زادت صعوبة التعليم، ورُميت اللغةُ بالعُسر، وما العُسرُ إلا في قُصورِ الوسائل أو فُتورِ الهِمم، فاتّهام اللغة بالصعوبة قد يكون طوق نجاة للطالب، وسترًا له يستر به فشله، وللمنظومة التعليمية أن ترمي بقصورها وضعفها على من لا يستطيع الدفاع عن نفسه، واللغة لا تستطيع الدفاع عن نفسها، ودفع هذه التهمة.
دعونا فيما تبقى من مساحة هذا المقال أن نسلط الضوء على خطورة الجانب النفسي، فحال المتعلم النفسية تجاه اللغة – قبل الشروع في تعلّمها – تُحدّد إلى درجة كبيرة مصير هذا التعلّم: نجاحًا أو فشلاً.
فالطالب الذي يُجبَر على دراسة العربية وهو لا يرى فيها إلا مادةً ثقيلة يجب اجتيازها للحصول على الشهادة، ولا يُبصر قيمتها الحضارية والفكرية والدينية، سيتعامل معها بفتورٍ ونفور، وسيكون أداؤه ضعيفًا؛ لغياب الدافع، ولعدم إدراك مكانتها، ودورها في حياته.
والمتعلّم الذي بنى تصوّرات سلبية عن اللغة قبل دراستها ستنعكس تلك التصوّرات على إقباله على التعلّم، والصبر على تجاوز العقبات، ماذا يسمع المتعلّم في هذا العصر عن تعلّم اللغة العربية؟ يسمع أنّ العربية “لغة معقدة”، وأنّ نحوها “متاهة لا مخرج منها”، وأنّ صرفها “ألغاز لا تُحلّ”، وأنّ إعرابها “عذاب لا ينقطع”، وأنّ عليه من أجل تعلّم العربية أن يتقن علومها، ونتيجة لذلك الخطاب امتلأت نفسه رهبةً وخوفًا، وصار مستعدًّا للفشل قبل أن يبدأ!
هذا المتعلم لن يكون كمن يتعلّم اللغة وهو يرى أنها من أعظم اللغات مكانةً وأوسعها ثراءً، وأنّ إتقانها شرفٌ ومكرمة، وأنّ فيها من الجمال والإحكام ما يستحقّ الجهد والمثابرة. الأول يدرس مُكرَهًا، والثاني يدرس مُحبًّا، فهل يستويان؟
يعرف علماء النفس ما يُسمّى النبوءة المحققة لذاتها، وهي نبوءة تصدق إن صدقناها، وتتحقق إذا اقتنعنا بها؛ لأن المرء سيسعى لتأكيدها، والعمل على تحققها، فالتوقّع السلبي قد يُنتج الفشل؛ لأنّ المتعلم استسلم مسبقًا، ولم يبذل الجهد الكافي، أو بذله وهو فاقدٌ للثقة.
فإذا قيل للطالب: “العربية صعبة”، صدّق، وإذا صدّق استسلم، وإذا استسلم فشل، وإذا فشل قال: “صدقوا! العربية فعلاً صعبة!”، وهكذا تدور الحلقة المفرغة، فتأملوا كيف أثّرت هذه المسألة في التعلّم، وهي جزء يتعلق بركن واحد من أركان التعليم، وما المتوقع إن انضمت إليه -في الاختلال- أركانٌ أخرى!
![]()
![]()