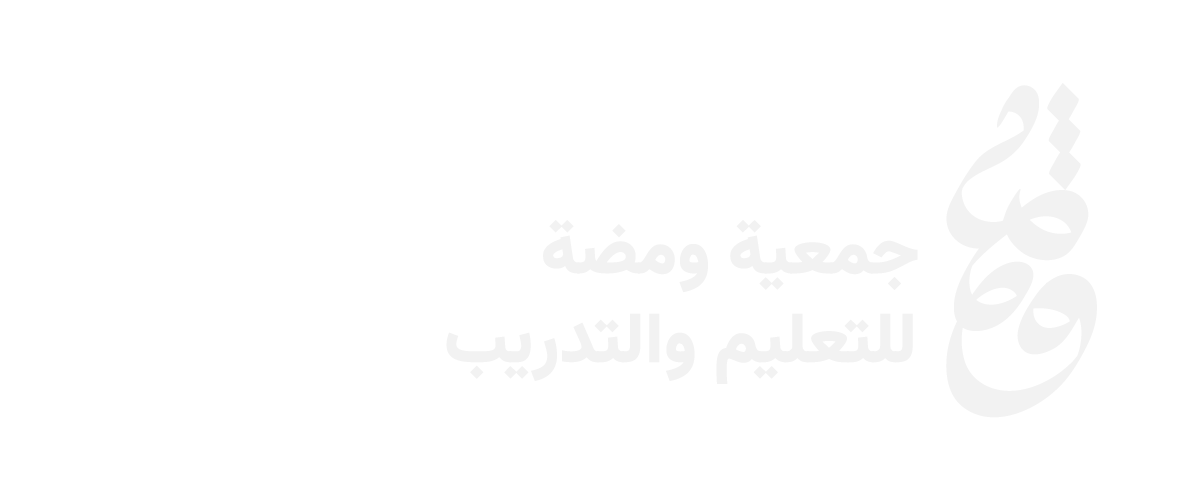وميض القلم 🖊️
العلاقة بين انتشار اللغة وسهولتها
من الحجج الشائعة التي يستدل بها كثيرون على “سهولة” لغة ما أو “صعوبتها”: كثرة متعلميها وانتشارها الواسع في العالم. فيقال مثلاً: “الإنجليزية لغة سهلة، ولذلك انتشرت في كل مكان وتعلمها الناس”. وبالمقابل يقال: “العربية صعبة معقدة، ولذلك محدودة الانتشار خارج العالم العربي”. وهذا خلط واضح بين المعايير المختلفة، وخطأ منهجي، فالانتشار اللغوي والإقبال على تعلم لغة ما يعودان إلى عوامل كثيرة ومتشابكة، ليس من بينها – في الغالب – “سهولة اللغة” أو “صعوبتها” في حد ذاتها، ولكن يعود إلى عوامل خارجيّة مؤثرة منها: القوة السياسية والعسكرية: فاللغات – في التاريخ البشري – تنتشر بانتشار نفوذ أهلها وقوتهم السياسية والعسكرية. فاللاتينية لم تنتشر في
![]()
![]()
موقع الحَزِّ وإصابة المفصل
حركة البناء في الاسم والضمير المتصل ربما جاز في مواضع أن تتغير لوجود وجهين كما في القراءات القرآنية (صراط الذين أنعمت عليهِم أو عليهُم) و(بما عاهدوا عليهُ الله، بضم الضمير المتصل بحرف الجر على) بشأن الضمير فحسب. كما أنه ورد في قراءة الكسائي ونافع وأبي جعفر المدني وشعبة صرف الاسم المشهور فيه المنع من الصرف كصيغة منتهى الجموع كقوله تعالى:{إنا أعتدنا للكافرين سلاسلًا وأغلالًا وسعيرا} فصُرِفت كلمة سلاسل وهي ممنوعة من الصرف لأنها صيغة منتهي الجموع. وورد في الشعر ضرورةً بشأن الاسم المجموع جمعًا مذكرًا سالمًا تغيير حركة بناء النون آخره نحو قول جرير: عرفنا جعفرًا وبني أبيهِ / وأنكرنا زعانفَ آخرينِ. إذ
![]()
![]()
العمل التطوعي.. حين يصبح العطاء مسارًا وطنيًا
في زمن تتسارع فيه وتيرة الحياة، ويغلب فيه الطابع المادي على كثير من مجالات العمل، يظل العمل التطوعي مساحة إنسانية خالصة، تعيد الاعتبار لمعنى العطاء، وتمنح الفرد فرصة حقيقية لترك أثر يتجاوز حدود الوظيفة والمسمى الوظيفي ليكون ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمعات؛ وانطلاقًا من هذا الدور الإنساني العميق، تتجلى أهمية العمل التطوعي في كونه الجسر الذي يربط بين طاقات الأفراد وخدمة المجتمع، ويمنح أصحاب الخبرات مجالًا أوسع للتأثير الإيجابي خارج الإطار الوظيفي التقليدي. إن مجتمعنا يزخر بكفاءات وطنية عالية، وخبرات تراكمت عبر سنوات طويلة من العمل والعطاء، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الطاقات لا يجد منصة مناسبة لتوظيف قدراته خارج الإطار
![]()
![]()
صعوبة العربيّة: واقع أم مبالغة؟
شاعت في زماننا مقولة “اللغة العربية لغةٌ معقّدةٌ عسيرةٌ، يَشِقُّ على المتعلّم إتقانُها” وغدت عند كثيرٍ من الناس من المُسلَّمات التي لا تُناقش، والبداهة التي لا يُشك فيها، وبات من يُعارض هذه المقولة أو يُشكّك فيها يُنظر إليه بعين الريبة: إمّا جاهلٌ بحقيقة اللغات، أو متعصّبٌ للعربية بغير وجه حقّ، يدفعه الحماس والعاطفة لا العلم والموضوعية! وهذه المقولة – على شيوعها وذيوعها – دعوى تفتقر إلى الدليل العلمي، قائمة في أحسن أحوالها – إذا استبعدنا التحيّز والأهواء عن أصحابها – على انطباعات شخصية لا ترقى إلى مرتبة الحقائق، وعلى تجارب فردية محدودة لا تصلح أساسًا للتعميم. فكيف صارت هذه الانطباعات حقيقة مطلقة؟ وبأيّ
![]()
![]()
عند الشدائد تذهب الأحقاد
إذا نزلتِ الشدائدُ، تهاوت الأحقادُ كما تتساقطُ أوراقُ الشجرِ اليابس عند هبوب الرياح العاصفة؛ إذ لا يثبتُ في ميدانِ المحنِ إلا صادقُ الودّ، ولا يصمدُ في ساعةِ الخطرِ إلا مَن طهّر قلبه من أدرانِ الضغائن. فالضغينةُ سوسُ الأخوّة، تنخرُ عظمها خفيةً، حتى إذا جاء يومُ الاحتشادِ والاعتصامِ وجدتها أوهى من بيتِ العنكبوت. وما كانت الأحقادُ يومًا زادًا في شدة، ولا كانت العداوةُ نصيرًا عند نزول البلاء؛ إنما هي وَهَنٌ يُلقي بصاحبه في مهبّ الريح، ويُفكِّك الصفَّ حين يُطلبُ التماسك، ويُشتِّت القلوبَ حين تُستنهَضُ للعهدِ والوقوف. فإذا ادلهمّت الخطوبُ، فليُلقِ المرءُ خلافَه وراء ظهره، ولينسَ ما كان من شحناء، وليشدَّ بأخيه عضده، فإن اليدَ
![]()
![]()
القراءة… حين يُعاد تشكيل الإنسان علمًا ووعيًا وأثرًا
لم تكن القراءة يومًا فعلًا ثقافيًا هامشيًا، بل كانت ولا تزال مدخلًا لصناعة الإنسان الواعي، وبناء العقل الراشد، وتهذيب السلوك. وقد دلّ الشرع والعقل والتجربة الإنسانية على أن القراءة ليست مجرد تحصيل معرفة، بل هي عبادة فكرية ومسؤولية حضارية. ويكفي القراءة شرفًا أن كانت أول أمرٍ إلهي نزل به الوحي، قال الله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: 1] وهذا يدل دلالة صريحة على أن القراءة أساس الاستخلاف، وبوابة العلم، وأول خطوات بناء الإنسان المؤمن الواعي. لقد صنعت مني القراءة عقلًا متأملًا لا يكتفي بظاهر الأمور، بل يسعى للفهم والتدبر، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ [محمد: 24] فالقراءة الحقيقية هي التي
![]()
![]()