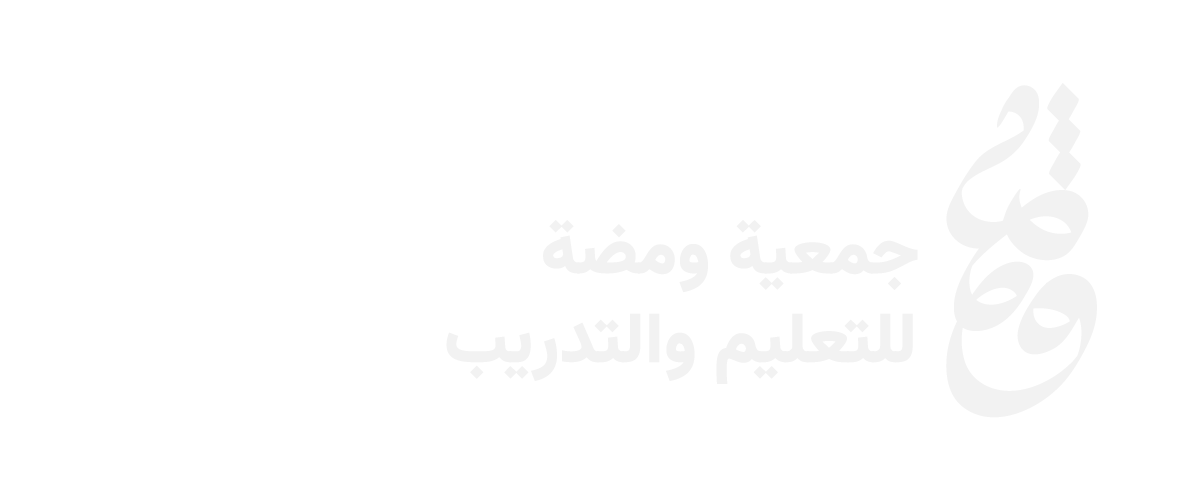من أمثال العرب قولهم: به داء الظبي في صحيح الجسم، ومعناه ليس به داء، كما أنه لا داء بالظبي..
عقبةٌ كؤود تحول بين المرء وقدراته، وتمنعه من التفكير في العمل الإيجابي، والمساهمة الجادة في نفع نفسه وغيره، وإنجاز اللبنة الصالحة المخولة إليه قبل أن تأخذ مكانها في بناء المجتمع العظيم، وصرحه الشامخ.
وكان من شأن الظبي التلكؤ ساعة قبل أن يقفز، والتباطؤ في الوثب من غير علة، ولو تلفتنا فيما حولنا لوجدنا ما هو أشد من داء الظبي؛ إذ الظبي يقفز، وإن بعد ضياع ما لا يحسن ضياعه من وقت.
ولعل القارئ الان يلاحق صور داء الظبي في المجتمع وهي كثيرة، ولكن دعونا نأخذ عينة من المجتمع والكشف عن أعراض ذاك الداء، وسنتجاوز بعض الفئات التي قد تكون بيئة صالحة حاضنة لانتشار داء الظبي، ونيمم شطر فئة من أبرز خصائصها الجد والاجتهاد، ومن أخص صفاتها المبادرة، ومن أغلى ما تملكه، وتدأب في الحرص عليه، الوقت..
نعم تلك الفئة طلاب العلم، أولئك الذين تتصرم لياليهم في المطالعة، وتنقضي أيامهم في الدرس، فكان الظن بهم الحصانة من ذاك الداء، والسلامة من هذا الوباء، ولكنّ المتصل بطلاب العلم يجد أعراض الداء ماثلة أمامه، يراها في ذاك الطالب الذي منذ سنوات، وهو يسأل عن أفضل طريقة لتطبيع القراءة ويلمحها في طالب آخر ما فتئ يبحث عن منهجية طلب العلم، وذاك الذي لم يتجاوز المتون ولا يزال يتهيب الصعود إلى أمهات الكتب الأصول…
أو ليس الطالب الذي أخذ على نفسه العهود والمواثيق بألا يشارك في نشر العلم بالتأليف والبحث والتدريس إلا بعد أن ينظر في العلم كله فلا تغيب عنه شاردة ولا واردة – وهيهات له ذلك – مكبلا بذاك الداء؟!
ومثله الطالب الذي تجاوز مرحلة التأصيل العلمي في العلوم الشرعية ولا يزال يتوجس ويشعر برهبة من مطالعة كتب الفكر ودواوين الأدب خوفا من التأثر بما فيها من انحرافات!!
إن تلك الصور نماذج لأعراض ذاك الداء، وإن أولئك جميعا بحاجة إلى العلاج؛ ليقفزوا ويثبوا ويشاركوا ويكفي ما ضاع من وقت، وما أُهدر من طاقات.