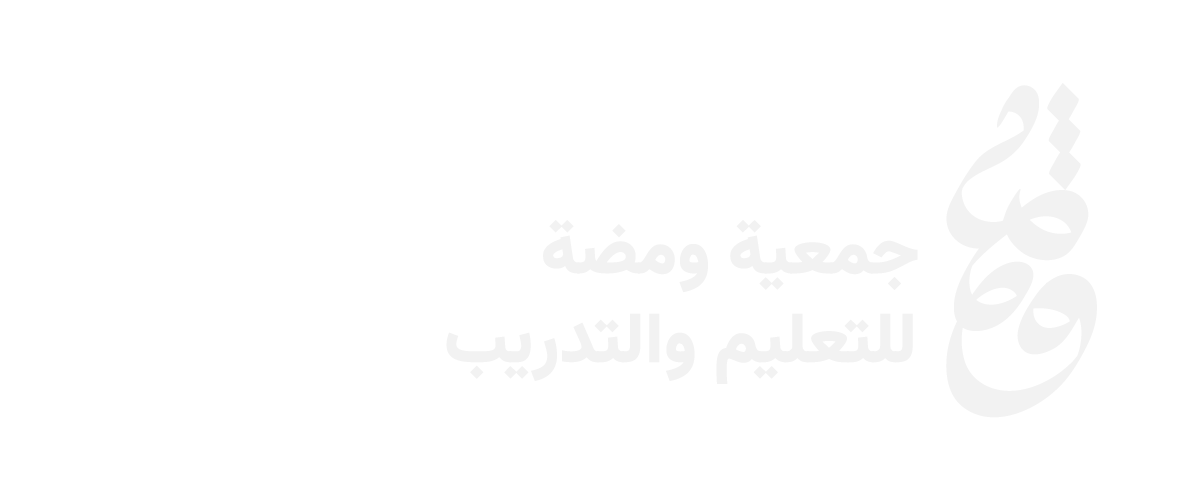لا يخفى على من اطلع على التراث العربي الثراء في الدراسات اللغوية، والمحاضرات الأدبية، والقضايا النقدية، وما يتبعها من تعدد في تصنيف النوادر، وتقييد الخواطر، وتأليف النكت، والتفنن في نظم العلم ونثره، وفي تلخيصه وشرحه، وضبط مصطلحاته، ورصد لتاريخ العلم ورجاله، وما أُنشئ من أجل خدمة النصوص العالية: القرآن الكريم وببيانه وإعرابه، والحديث النبوي وغريبه، والشعر وشرحه وتفسيره، وكذلك رواية شعر الشعراء ونثر الأدباء، وما يحتف به من سياق المقام، ومن سيرة الشاعر ومن رد واعتراضات ونقد، و الموازنة بينهم، واستنباط أصول المعايير النقدية، وطرائق صناعة الذوق ومحاولة تأصيل البلاغة، وتقعيد الفصاحة، وبناء ما من شأنه أن يبقي كلام العرب بقواعده وسننه؛ لينحو نحوهم من رام كلامهم.
ومن جهة أخرى لا يخفى على المشتغلين بالعلم والأدب ضرورة تنويع المقروء، وأهمية النظر في أنواع التصنيف، وخطورة الاكتفاء بنمط تأليفي واحد، والاعتياد عليه، فلا يستطيع تجاوزه، ولا فهم مسائل العلم إلا بواسطته، وما يتبع ذلك من تأثير في تصور العلم، ولاشك أن سعة الاطلاع مع التأصيل لهما أثرهما في تكوين عقلية طالب العلم، فيجب على طالب العلم الحرص على تنوع المقروء في علوم العربية كلها، وفي العلم الواحد من كتاب تقعيد وبيانه، و متن وشرحه إلى كتب تطبيقية، وإدمان النظر في كلام العرب، وفي ذلك كثير من الفوائد منها: معرفة لوازم الأقوال، وتثبيت القواعد والأصول، و الوقوف على المسائل غير المبوبة في كتب القواعد واتساع دائرة النظر، ومعرفة مظان المعرفة، ومواطن بحث المسائل، والوقوف على التطبيقات وردم الهوة التي بين التنظير والتطبيق، واكتساب مهارة تخريج المسائل غير المنضبطة، والوقوف على إشكالات العلم؛ من أجل الإسهام في حلها، ومحاولة تجديد العلم وبعثه.
وبناء على الجهة الأولى والأخرى ينبغي لطالب العلم تنويع المقروء، وعدم الاقتصار على بعض الكتب المدرسية، أو التوصيات المنهجية، فمقام القراءة والثقافة والبحث يختلف عن مقام التأصيل في أول الطريق العلمي.